أالقلوب. ومفسداتها
إن هذا القلب هو الملك على سائر الأعضاء وهو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله) ولما كان القلب هو الملك والجوارح هي الجنود المؤتمرة بأمره، ولما كان هو المسئول عن الرعية، وهو الراعي والجوارح هي رعيته، لما علم عدو الله إبليس بذلك أجلب على هذا القلب بالوساوس والشهوات، وصار يحاول إفساد قلوب بني آدم بشتى الوسائل التي يستطيعها، وما ذلك إلا أنه قد أخذ على نفسه العهد بأن يفسد من ذرية آدم من يستطيع، والله استثنى خلقا من خلقه، فقال: "إلا عبادي" هؤلاء العباد ليس لك عليهم سلطان، عباد الله المتقون، وأما الناس الغافلون وأصحاب الشهوات والشبهات، فإن لكل منهم نصيبا من الشيطان، بحسب الضلال الذي أضله به، ولا يمكن أن ينجو الإنسان يوم القيامة إلا إذا جاء بقلب سليم من الشهوات والشبهات، كما قال الله عز وجل: {يوم لا ينفع مال ولا بنون * إلا من أتى الله بقلب سليم} [الشعراء:88 - 89].
نواع القلوب
كما أن إضلال الشيطان لقلوب العباد على أنواع ومراتب
فإن القلوب أنواع كذلك بحسب أصحابها
فمن القلوب:
القلب الأول: قلب أسود مرباد كالكوز مجخ قلب أغلف وذلك هو قلب الكافر لا يدخل إليه النور ولا ينتفع بشيء.
القلب الثاني: قلب منكوس فيه مرض وهو قلب المنافق.
القلب الثالث: وقلب فيه من النور الإيماني الرحماني ومن شهوات الشيطان والشبهات خلط فيمده ميزابان ميزاب النور الإيماني وميزاب الشهوات والشبهات الشيطانية فهو لما غلب عليه منهما فإن كان الأغلب عليه نور الرحمن فإنه ينجو وإن كان الأغلب عليه مداد الشيطان فإنه يهلك.
القلب الرابع: قلب المخبتين الذين تخبت قلوبهم لذكر الله وتلين جلودهم لربهم سبحانه وتعالى وهذا قلب المؤمن الخالص.
وقلوبنا أيها الإخوة
نحن الضعفاء قلوب فيها الخلط والأمور المختلفة فيها ما يرضي الله وما لا يرضيه ولذلك فإن المسلم مطالب بتنقية قلبه وهناك أشياء تصلح القلب ذكرنا بعضها ولا يتسع المجال لذكر أمر آخر من الأمور التي تصلح القلب كالاستطراد في ذكر الله مثلا فإنه مما يصلح القلب والعبادات على تنوعها تصلح القلب وهكذا من أنواع الخوف والرجاء والمحبة والمحاسبة والمراقبة والطمأنينة والحياء والمراتب الأخرى التي هي أخلاق القلوب و اجتناب المفسدات من أعظم وسائل إصلاح القلوب فإن المسألة جلب مصالح ودرء مفاسد.
فإن القلوب أنواع كذلك بحسب أصحابها
فمن القلوب:
القلب الأول: قلب أسود مرباد كالكوز مجخ قلب أغلف وذلك هو قلب الكافر لا يدخل إليه النور ولا ينتفع بشيء.
القلب الثاني: قلب منكوس فيه مرض وهو قلب المنافق.
القلب الثالث: وقلب فيه من النور الإيماني الرحماني ومن شهوات الشيطان والشبهات خلط فيمده ميزابان ميزاب النور الإيماني وميزاب الشهوات والشبهات الشيطانية فهو لما غلب عليه منهما فإن كان الأغلب عليه نور الرحمن فإنه ينجو وإن كان الأغلب عليه مداد الشيطان فإنه يهلك.
القلب الرابع: قلب المخبتين الذين تخبت قلوبهم لذكر الله وتلين جلودهم لربهم سبحانه وتعالى وهذا قلب المؤمن الخالص.
وقلوبنا أيها الإخوة
نحن الضعفاء قلوب فيها الخلط والأمور المختلفة فيها ما يرضي الله وما لا يرضيه ولذلك فإن المسلم مطالب بتنقية قلبه وهناك أشياء تصلح القلب ذكرنا بعضها ولا يتسع المجال لذكر أمر آخر من الأمور التي تصلح القلب كالاستطراد في ذكر الله مثلا فإنه مما يصلح القلب والعبادات على تنوعها تصلح القلب وهكذا من أنواع الخوف والرجاء والمحبة والمحاسبة والمراقبة والطمأنينة والحياء والمراتب الأخرى التي هي أخلاق القلوب و اجتناب المفسدات من أعظم وسائل إصلاح القلوب فإن المسألة جلب مصالح ودرء مفاسد.
مفسدات القلوب
من مفسدات القلب أيها الإخوة
خمسة مفسدات مرتبطة ببعضها البعض
وهي كثرة الخلطة
والتمني
والتعلق بغير الله
والشبع
وكثرة النوم
كثرة الاختلاط بالناس
أيها الإخوة! إن كثرة الاختلاط بالناس اختلاطا شديدا بحيث لا يبقى للإنسان وقت يتفرغ فيه لنفسه ولا يتفطن فيه لعيوبه ولا يصلح فيه قلبه كثرة الخلطة مسألة سيئة يتسبب عن كثرة الخلطة وإمتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم، حتى يسود ويسبب تشتت القلب وتفرقه ويسبب الهم والغم وإضاعة المصالح والاشتغال بقرناء السوء وينقسم الفكر عند كثرة الاختلاط بالناس الاختلاط غير الشرعي يقسم الفكر في أودية مطالب هؤلاء المخالطين يتقسم الفكر في أودية مطالبهم وإراداتهم فماذا سيبقى في القلب لله والدار الآخرة؟! وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة، وأنزلت من محنة وعطلت من منحة وأحلت من رزية وأوقعت في بلية؟ وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان أضر على أبي طالب من قرناء السوء؟ فلم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة توجب له سعادة الأبد وهي كلمة التوحيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسه يقول: يا عم قل كلمة كلمة حق أشفع لك بها عند الله قل: لا إله إلا الله، وأبو جهل وغيره من عتاة قريش على رأسه من الجانب الآخر يقولون: تموت على غير ملة عبد المطلب، وهو يقول:
إني لأعلم أن دين محمد من خير أديان البرية دينا
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا
فـ أبو طالب يعلم بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم خير أديان البرية دينا لكن يمنعه عن قول لا إله إلا الله الملامة أو حذار مسبة أن يلومه قومه أو يسبوه بعد موته ويقولون: مات على غير ملة آبائه وأجداده فهذه الخلطة الشنيعة سببت هذا الوبال الذي حل بـ أبي طالب ألم يقل الله عن أناس من أهل النار يعتذرون فيقولون:ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا} فيقال لهم: {النار مثواكم} وهؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا كما قال الله عز وجل: {وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين} .
اجتماع الناس في مودة على شيء لا يرضي الله، سيكفر بعضهم ببعض يوم القيامة على هذا الاجتماع الذي اجتمعوا عليه وكثير من الناس الآن يلتقون على مودة لكن أي مودة؟ {مودة بينكم في الحياة الدنيا} اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا، التقوا مودة، لكنها مودة شركية كفرية، مودة معاص وأهواء وشهوات هذه الذي اجتمعوا عليها ففي يوم القيامة سيكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا فهذه الخلطة المحرمة، وهذه الخلطة بقرناء السوء هي التي ستردي صاحبها في نار جهنم، فيكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا ومأواهم النار وما لهم من ناصرين.
فإن قال قائل هل الخلطة أصلا محرمة؟ وهل الإنسان مطالب أن يعيش وحدانيا ليس له صاحب ولا صديق؟ فنقول: أبدا ليس الأمر كذلك فإن الإنسان خلق اجتماعيا بطبعه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل الناس ذوي أشكال أو أرواح فيها تجاذب وفيها تنافر والناس يميل بعضهم إلى بعض ويرتاح بعضهم إلى بعض أقسام وجماعات وشيع لكن لا بد أن نقول: إن الخلطة منها ما هو شرعي مثل ما خاطب الله المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة .
معناه: أن المسلم مطالب أن يكون في جماعة إذا لم يكن في جماعة يشذ ومن شذ شذ في النار.
وإذا لم يكن في جماعة فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية لأن الجماعة هي التي تقويه وتشد أزره وتغذي وريد إيمانه وهي التي تشجعه فيتقوى بعضهم ببعض وتنعقد أواصر الأخوة في الله، إذا: الجماعة الصالحة مطلوب من المسلم أن يختلط بها ومطلوب من المسلم أن ينضوي تحت لوائها ومطلوب من المسلم أن يكون فردا من أفرادها المجموعة الصالحة والرفقة الطيبة لا بد من الاختلاط بها فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة فلا يمكن للإنسان أن يقول: إننا من أجل إصلاح القلوب ينبغي أن نعيش منفردين ولا نخالط الناس لكن أين الخطأ وأين الخطر؟
والخطر في مخالطة أهل السوء والاجتماع بقرناء السوء وهذه الوحشة التي تحصل من امتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم الذين دائما يسيرون على الخطأ ولا يتوبون إلى الله ولا يرجعون هؤلاء أنفاسهم دخان ينعقد في القلب، فيعلون القلب من هذا النتن ومن هذا الران مالا يعلمه إلا الله.
فإن قال قائل: أعطنا ضابطا يضبط لنا الأمور في الاختلاط الجيد والاختلاط الرديء فنقول: إذا خالطت الناس في الخير كالجمعة والجماعات، والأعياد والحج، وتعلم العلم والجهاد في سبيل الله والنصيحة، فهذا اختلاط محمود بل هو مطلوب شرعا وينبغي عليك أن تفعل ذلك وأن تعتزلهم في الشر وفضول المباحات فإذا رأيتهم على لهو ولعب ومعاص وفسوق فلا يجوز لك أن تختلط بهم.
وإن قال قائل: إن الأوضاع اليوم لا تيسر لنا اجتماعا دائما على الخير فإنني موظف في شركة وطالب في مدرسة وعضو في جامعة، وهذه الشركة، أو المدرسة، أو الجامعة لا بد أن أذهب إليها، بحكم الدراسة والدوام، ولا بد أن أختلط بالطلبة والموظفين والناس الذين في ذلك المحل، وإنني تاجر وأختلط بالزبائن، فكيف أفعل؟ هل أترك هذه الأماكن لأن فيها سوءا؟ فإن الأسواق فيها سوء وكثير من المدارس قد يكون فيها سوء والشركات فيها سوء
فهل أترك الخلطة في عملي في المستشفى أو الدائرة أو الشركة وما إلى ذلك من أنوع أماكن التجمعات التي يتجمع فيها الناس لكي يعيشوا في وظائف أو يعيشوا من الوظائف هذه في هذه التجمعات، هل أترك ذلك؟ فنقول: إن الاختلاط هنا أمر صار شبه مفروض عليك، ولا تستطيع أن تترك الاختلاط بهؤلاء الناس في الشركة أو المستشفى أو المدرسة أو الجامعة أو السوق، فإذا دعتك الحاجة إلى خلطتهم، ولم يمكنك اعتزالهم وهم يفعلون أمورا من الشر لأنك لن تعدم أحدا يدخن أو يغتاب أو يلعب الألعاب المحرمة أو يأتي بمنكرات في المجلس الذي أنت فيه سواء في الشركة أو الجامعة أو السوق أو المستشفى، أو المكان الذي أنت موجود فيه ولا يمكن أن نقول للناس: عطلوا المستشفيات لأن فيها اختلاطا وغادروا الشركات لأن فيها مدراء سوء واتركوا الجامعات لأن فيها شللا منحرفة بل نحن مطالبون بالإصلاح ومطالبون بأن يكون لنا دور عملي نغير به الواقع فيكون واقعا يرضي الله عز وجل فأنت طبيب في المستشفى فلا بد أن تغير الواقع وتسعى في تغييره ليكون مرضيا لله، فتقاوم الاختلاط والسفور والخلوة المحرمة وأنت طالب في المدرسة ينبغي أن تدافع المنكرات وتغير الواقع وتقاوم قرناء السوء، وتقاوم الصورة المحرمة، والفلم المحرم الذي قد يجلب والألعاب المحرمة، والنكت والطرائف المحرمة وأنت في السوق ينبغي أن تقاوم البيوع المحرمة والتعامل الحرام مع الزبائن والتحدث مع النساء مع تكسرهن في الكلام ودعوتهن بالشهوات والمظاهر التي تجلب الشقاء للنفس إذا: نحن مهمتنا المدافعة وتغيير المنكر إلى ما يرضي الله عز وجل.
فإذا دعتنا الظروف لأن نكون مختلطين في هذا الواقع فماذا نفعل؟ لأن الواقع هذا قد يفسد القلب أو يقسيه إنهم أناس لا يتورعون عن فعل الشر وفي نفس الوقت لا يمكن أن نتركهم ولا بد أن نختلط بهم في حكم عملنا وهذا مجال كسب ووظيفة ولا بد أن نكون فيه
فما هو الحل؟
فإذا دعت الحاجة إلى خلطتهم وهم على أمور من المنكرات والشر ولا يمكنك اعتزالهم أبدا لأنه قد يمكن اعتزالهم في الشر وإذا جاء وقت المباحات أو الخير اختلطت بهم لكن إذا لم يمكن فالحذر الحذر أن توافقهم على منكرهم وشرورهم وأن تصبر على أذاهم لأنك ستدعو وتواجه بأنواع من الأذى لأنه لا يمكن للإنسان أن يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر دون أن يلقى أذى فإذا لم يجد الأذى معناه أن في سيره خطأ إما أنه يداهن أو شيء من هذا القبيل، وإذا لم يجد في إنكاره أذى أبدا، فمعنى أن في إنكاره خطأ، طبعا لا يشترط أن يكون الأذى كل مرة، فقد يجد قلبا متفتحا وأذنا سامعة، وإنسانا مستجيبا ويثني عليه، فلا يشترط أن يجد الأذى كل مرة ولكن في أحوال كثيرة أو في بعض الأحيان لا بد أن يجد شيئا من الأذى فالحذر أن توافقهم واصبر على أذاهم.
وإذا دعتك الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات، في أشياء من المباحات فاجتهد أن تقلب ذلك المجلس طاعة لله وأن تشجع نفسك على هذا الأمر وأن لا تستجيب للشيطان إذا قال لك هذا رياء وأنت تريد أن تقلب المجلس إلى مجلس ذكر وأن تفتح مواضيع إسلامية أنت مراء أنت تريد أن تبرز بينهم على أنك أنت الشيخ وأنت الواعظ المذكر وهذا رياء فلا تستجب للشيطان وادع وذكر: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين} واستعن بالله عليهم وأخلص في عملك فإن أعجزتك المقادير فلم تستطع أن تغير أو أن تقلب المجلس إلى مجلس ذكر
فماذا تفعل؟ قال: ابن القيم رحمه الله فيمن هذا شأنه: فليسل قلبه من بينهم سل الشعرة من العجين وليكن فيهم حاضرا غائبا قريبا بعيدا نائما يقظا ينظر إليهم ولا يبصرهم ويسمع كلامهم ولا يعيه لأنه قد أخذ قلبه من بينهم ورقى به إلى الملأ الأعلى، وما أصعب هذا وما أشقه على النفوس وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه.
من مفسدات القلب أيها الإخوة
خمسة مفسدات مرتبطة ببعضها البعض
وهي كثرة الخلطة
والتمني
والتعلق بغير الله
والشبع
وكثرة النوم
كثرة الاختلاط بالناس
أيها الإخوة! إن كثرة الاختلاط بالناس اختلاطا شديدا بحيث لا يبقى للإنسان وقت يتفرغ فيه لنفسه ولا يتفطن فيه لعيوبه ولا يصلح فيه قلبه كثرة الخلطة مسألة سيئة يتسبب عن كثرة الخلطة وإمتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم، حتى يسود ويسبب تشتت القلب وتفرقه ويسبب الهم والغم وإضاعة المصالح والاشتغال بقرناء السوء وينقسم الفكر عند كثرة الاختلاط بالناس الاختلاط غير الشرعي يقسم الفكر في أودية مطالب هؤلاء المخالطين يتقسم الفكر في أودية مطالبهم وإراداتهم فماذا سيبقى في القلب لله والدار الآخرة؟! وكم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة، وأنزلت من محنة وعطلت من منحة وأحلت من رزية وأوقعت في بلية؟ وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان أضر على أبي طالب من قرناء السوء؟ فلم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة توجب له سعادة الأبد وهي كلمة التوحيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسه يقول: يا عم قل كلمة كلمة حق أشفع لك بها عند الله قل: لا إله إلا الله، وأبو جهل وغيره من عتاة قريش على رأسه من الجانب الآخر يقولون: تموت على غير ملة عبد المطلب، وهو يقول:
إني لأعلم أن دين محمد من خير أديان البرية دينا
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا
فـ أبو طالب يعلم بأن دين محمد صلى الله عليه وسلم خير أديان البرية دينا لكن يمنعه عن قول لا إله إلا الله الملامة أو حذار مسبة أن يلومه قومه أو يسبوه بعد موته ويقولون: مات على غير ملة آبائه وأجداده فهذه الخلطة الشنيعة سببت هذا الوبال الذي حل بـ أبي طالب ألم يقل الله عن أناس من أهل النار يعتذرون فيقولون:ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا} فيقال لهم: {النار مثواكم} وهؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا كما قال الله عز وجل: {وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين} .
اجتماع الناس في مودة على شيء لا يرضي الله، سيكفر بعضهم ببعض يوم القيامة على هذا الاجتماع الذي اجتمعوا عليه وكثير من الناس الآن يلتقون على مودة لكن أي مودة؟ {مودة بينكم في الحياة الدنيا} اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا، التقوا مودة، لكنها مودة شركية كفرية، مودة معاص وأهواء وشهوات هذه الذي اجتمعوا عليها ففي يوم القيامة سيكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا فهذه الخلطة المحرمة، وهذه الخلطة بقرناء السوء هي التي ستردي صاحبها في نار جهنم، فيكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا ومأواهم النار وما لهم من ناصرين.
فإن قال قائل هل الخلطة أصلا محرمة؟ وهل الإنسان مطالب أن يعيش وحدانيا ليس له صاحب ولا صديق؟ فنقول: أبدا ليس الأمر كذلك فإن الإنسان خلق اجتماعيا بطبعه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل الناس ذوي أشكال أو أرواح فيها تجاذب وفيها تنافر والناس يميل بعضهم إلى بعض ويرتاح بعضهم إلى بعض أقسام وجماعات وشيع لكن لا بد أن نقول: إن الخلطة منها ما هو شرعي مثل ما خاطب الله المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة .
معناه: أن المسلم مطالب أن يكون في جماعة إذا لم يكن في جماعة يشذ ومن شذ شذ في النار.
وإذا لم يكن في جماعة فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية لأن الجماعة هي التي تقويه وتشد أزره وتغذي وريد إيمانه وهي التي تشجعه فيتقوى بعضهم ببعض وتنعقد أواصر الأخوة في الله، إذا: الجماعة الصالحة مطلوب من المسلم أن يختلط بها ومطلوب من المسلم أن ينضوي تحت لوائها ومطلوب من المسلم أن يكون فردا من أفرادها المجموعة الصالحة والرفقة الطيبة لا بد من الاختلاط بها فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة فلا يمكن للإنسان أن يقول: إننا من أجل إصلاح القلوب ينبغي أن نعيش منفردين ولا نخالط الناس لكن أين الخطأ وأين الخطر؟
والخطر في مخالطة أهل السوء والاجتماع بقرناء السوء وهذه الوحشة التي تحصل من امتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم الذين دائما يسيرون على الخطأ ولا يتوبون إلى الله ولا يرجعون هؤلاء أنفاسهم دخان ينعقد في القلب، فيعلون القلب من هذا النتن ومن هذا الران مالا يعلمه إلا الله.
فإن قال قائل: أعطنا ضابطا يضبط لنا الأمور في الاختلاط الجيد والاختلاط الرديء فنقول: إذا خالطت الناس في الخير كالجمعة والجماعات، والأعياد والحج، وتعلم العلم والجهاد في سبيل الله والنصيحة، فهذا اختلاط محمود بل هو مطلوب شرعا وينبغي عليك أن تفعل ذلك وأن تعتزلهم في الشر وفضول المباحات فإذا رأيتهم على لهو ولعب ومعاص وفسوق فلا يجوز لك أن تختلط بهم.
وإن قال قائل: إن الأوضاع اليوم لا تيسر لنا اجتماعا دائما على الخير فإنني موظف في شركة وطالب في مدرسة وعضو في جامعة، وهذه الشركة، أو المدرسة، أو الجامعة لا بد أن أذهب إليها، بحكم الدراسة والدوام، ولا بد أن أختلط بالطلبة والموظفين والناس الذين في ذلك المحل، وإنني تاجر وأختلط بالزبائن، فكيف أفعل؟ هل أترك هذه الأماكن لأن فيها سوءا؟ فإن الأسواق فيها سوء وكثير من المدارس قد يكون فيها سوء والشركات فيها سوء
فهل أترك الخلطة في عملي في المستشفى أو الدائرة أو الشركة وما إلى ذلك من أنوع أماكن التجمعات التي يتجمع فيها الناس لكي يعيشوا في وظائف أو يعيشوا من الوظائف هذه في هذه التجمعات، هل أترك ذلك؟ فنقول: إن الاختلاط هنا أمر صار شبه مفروض عليك، ولا تستطيع أن تترك الاختلاط بهؤلاء الناس في الشركة أو المستشفى أو المدرسة أو الجامعة أو السوق، فإذا دعتك الحاجة إلى خلطتهم، ولم يمكنك اعتزالهم وهم يفعلون أمورا من الشر لأنك لن تعدم أحدا يدخن أو يغتاب أو يلعب الألعاب المحرمة أو يأتي بمنكرات في المجلس الذي أنت فيه سواء في الشركة أو الجامعة أو السوق أو المستشفى، أو المكان الذي أنت موجود فيه ولا يمكن أن نقول للناس: عطلوا المستشفيات لأن فيها اختلاطا وغادروا الشركات لأن فيها مدراء سوء واتركوا الجامعات لأن فيها شللا منحرفة بل نحن مطالبون بالإصلاح ومطالبون بأن يكون لنا دور عملي نغير به الواقع فيكون واقعا يرضي الله عز وجل فأنت طبيب في المستشفى فلا بد أن تغير الواقع وتسعى في تغييره ليكون مرضيا لله، فتقاوم الاختلاط والسفور والخلوة المحرمة وأنت طالب في المدرسة ينبغي أن تدافع المنكرات وتغير الواقع وتقاوم قرناء السوء، وتقاوم الصورة المحرمة، والفلم المحرم الذي قد يجلب والألعاب المحرمة، والنكت والطرائف المحرمة وأنت في السوق ينبغي أن تقاوم البيوع المحرمة والتعامل الحرام مع الزبائن والتحدث مع النساء مع تكسرهن في الكلام ودعوتهن بالشهوات والمظاهر التي تجلب الشقاء للنفس إذا: نحن مهمتنا المدافعة وتغيير المنكر إلى ما يرضي الله عز وجل.
فإذا دعتنا الظروف لأن نكون مختلطين في هذا الواقع فماذا نفعل؟ لأن الواقع هذا قد يفسد القلب أو يقسيه إنهم أناس لا يتورعون عن فعل الشر وفي نفس الوقت لا يمكن أن نتركهم ولا بد أن نختلط بهم في حكم عملنا وهذا مجال كسب ووظيفة ولا بد أن نكون فيه
فما هو الحل؟
فإذا دعت الحاجة إلى خلطتهم وهم على أمور من المنكرات والشر ولا يمكنك اعتزالهم أبدا لأنه قد يمكن اعتزالهم في الشر وإذا جاء وقت المباحات أو الخير اختلطت بهم لكن إذا لم يمكن فالحذر الحذر أن توافقهم على منكرهم وشرورهم وأن تصبر على أذاهم لأنك ستدعو وتواجه بأنواع من الأذى لأنه لا يمكن للإنسان أن يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر دون أن يلقى أذى فإذا لم يجد الأذى معناه أن في سيره خطأ إما أنه يداهن أو شيء من هذا القبيل، وإذا لم يجد في إنكاره أذى أبدا، فمعنى أن في إنكاره خطأ، طبعا لا يشترط أن يكون الأذى كل مرة، فقد يجد قلبا متفتحا وأذنا سامعة، وإنسانا مستجيبا ويثني عليه، فلا يشترط أن يجد الأذى كل مرة ولكن في أحوال كثيرة أو في بعض الأحيان لا بد أن يجد شيئا من الأذى فالحذر أن توافقهم واصبر على أذاهم.
وإذا دعتك الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات، في أشياء من المباحات فاجتهد أن تقلب ذلك المجلس طاعة لله وأن تشجع نفسك على هذا الأمر وأن لا تستجيب للشيطان إذا قال لك هذا رياء وأنت تريد أن تقلب المجلس إلى مجلس ذكر وأن تفتح مواضيع إسلامية أنت مراء أنت تريد أن تبرز بينهم على أنك أنت الشيخ وأنت الواعظ المذكر وهذا رياء فلا تستجب للشيطان وادع وذكر: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين} واستعن بالله عليهم وأخلص في عملك فإن أعجزتك المقادير فلم تستطع أن تغير أو أن تقلب المجلس إلى مجلس ذكر
فماذا تفعل؟ قال: ابن القيم رحمه الله فيمن هذا شأنه: فليسل قلبه من بينهم سل الشعرة من العجين وليكن فيهم حاضرا غائبا قريبا بعيدا نائما يقظا ينظر إليهم ولا يبصرهم ويسمع كلامهم ولا يعيه لأنه قد أخذ قلبه من بينهم ورقى به إلى الملأ الأعلى، وما أصعب هذا وما أشقه على النفوس وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه.
التمني
ثانيا: التمني
فإنه من مفسدات القلب وهو بحر لا ساحل له يركبه مفاليس العالم والمنى رأس أموال المفاليس والمفلس هو الذي ليس عنده أعمال صالحة أو ليس عنده عطاء لهذا الدين ماذا يفعل لكي ينجو من لوم النفس إذا لامته، أو ينجو من تأنيب الضمير إذا أنبه؟
يعلق النفس بالأماني ويقول: سيغفر الله لي أليس الله بغفور رحيم! فلا تزال أمواج الأماني الكاذبة تتلاعب براكب بحر التمني وكل حسب حاجته فمنهم من يعتمد على رحمة الله ويعصي ويحلم بالأماني ويحلم بجنة عرضها السماوات والأرض ولكن لا يفكر في أنها أعدت للمتقين هؤلاء المتكلون على رحمة الله مما ضيعهم مسألة مهمة جدا ما هي؟ إذا تأملت حالهم وجدتهم ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم هذه عبارة مهمة جدا ذكرها علماؤنا ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم هؤلاء أصحاب الأماني ما هي مشكلتهم ومصيبتهم؟
إنهم ينظرون في حقهم على الله فيقولون: لا بد أن الله يغفر لنا فنحن موحدون ونحن مسلمون قلنا: لا إله إلا الله، أليس من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة؟ أليس؟ أليس؟ أكيد أن الله سيغفر لنا فينظرون في حقهم على الله والآن كل تفكيرهم وجل همهم ماذا سيفعل الله لهم من أنواع النعيم المقيم وجنات النعيم، ولكنهم لا يفكرون في حق الله عليهم، لو فكروا في حق الله عليهم وأنهم ينبغي أن يعبدوه وأن يصلحوا شأنهم معه؛ لعرفوا تقصيرهم، ولعرفوا أنهم مهما قدموا من الصالحات فلا يزالون مقصرين، إلا إذا تداركهم الله برحمته و (لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته).
فإذا: هذا التمني من الدواهي التي تصيب القلب فتهلكه لأن الإنسان لا يزال في أحلام وتخيلات في أنواع الجزاء الذي سيأخذه يوم القيامة وهو قد نأى بنفسه عن التفكير في حق الله عليه.
ومن الناس من يجعل تمنياته في القدرة والسلطان فيحلم وينظر إلى المستقبل أو ينظر إلى نفسه يتمنى أن يكون أميرا أو كبيرا أو وزيرا أو رئيسا أو زعيما أو مديرا أو نائب مدير أو نائب المدير العام ونحو ذلك من الأشياء.
ومنهم من أمانيه في الضرب في الأرض والتطواف في البلدان في السياحات ورؤية البلدان والمناظر الخلابة إلخ.
وهذا أمانيه محصورة بهذا الجانب ومنهم أناس من أمنياتهم أو أمانيهم في الأموال والأثمان تاجر وربح وكسب وتضاعف رأس ماله ولا خسارة تذكر وهكذا وتوسعت الشركات وفتحت الفروع وعملت الأعمال وهكذا فهو محصور في عملية الأثمان والأموال والتجارات وكل متمن بحسبه.
ومشكلة التمني أنه يصور الأمر لهذا المتمني أنه قد فاز بمطلوبه لأنه عندما يفكر أنه قد وصل وأنه حصل على هذه الأشياء وهذا مجرد تفكير وخيالات يرتاح فيها مؤقتا ويلتذ لذة وهمية لأنه لم يحصل له شيء من هذا، وإنما هي أمنيات فبينما هو على هذه الحال إذا استيقظ فوجد الحصير في يده ليس عنده إلا الحصير.
فلابد أن نقف وقفة بسيطة نقول: هل خطأ أن الإنسان يتمنى مالا أو غنى أو جاها هل هذا خطأ في الشرع نقول: لا.
لكن الخطأ ورد في حديث مهم جدا ذكره عليه الصلاة والسلام: ذكر أربعة من الرجال وذكر أحوالهم فكان مما قاله في أحد الأحاديث: (ورجل يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان) إنسان غني يعمل صالحات وينفق أموالا وزكوات وصدقات وكفالة أيتام ويبني المساجد ويعمل الملاجئ والأوقاف وآخر يقول: لو أن لي مال فلان لعملت بعمله وكلمة لو أن لي مال فلان تعتبر تمنيا وهذا هو التمني المحمود لأنه يتمنى لو أن له مال فلان لعمل فيه بعمل فلان أي لتصدق وزكى وأنفق وبنى المساجد وكفل الأيتام وتصدق على الفقراء وأخرج المجاهدين وعمل أوقافا إلى آخره، وطبع الكتب، ودعم الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية وعمل مراكز ربما في الخارج وأنفق على دعاة وجعل رواتب للدعاة لكي يتفرغوا للدعوة وفكر في أشياء هذا الإنسان يؤجر على أمنيته يؤجر على نيته الطيبة ولو ما عنده مال يقول عليه الصلاة والسلام: (فهما في الأجر سواء).
وآخر عنده مال عمل فيه بمعصية الله سافر السفريات المحرمة وأنفق الأموال على أهل الفواحش وأرباب الفسق وقرناء السوء وظلم في هذه المال وقطع رحما ومنع زكاة ولم يكن من المصلين ولم يحض على طعام المسكين ونهر السائل وقهر اليتيم الخ.
هذا إنسان آثم ولا شك وشخص آخر يقول: لو أن لي مال فلان لعملت بعمله لو أن لي مال فلان، لركبت السيارات، ولبست الساعة الذهب الفلانية وسافرت إلى المحلات الفلانية وعملت الفواحش وعملت الموبقات ووضعت في البنك الربوي الفلاني وجاءتني الفوائد الفلانية إذا: هذا الإنسان ليس له مال لكن مجرد الأمنية هذه يأثم عليها فيقول: عليه الصلاة والسلام: (فهما في الوزر سواء) مع أنه ليس له مال ولكن تصور حتى تعلم أن القلب يعبد الله أو يعصي الله يؤجر على ما في القلب ويأثم على ما في القلب، وهذا الإثم من إنسان مريد عاقد النية، لو كان له مال فلان لعمل فيه وهذا غير الخواطر لأنه قد يقول قائل: إن الإنسان لا يأثم على الخواطر نقول: نعم.
لا يأثم على الخواطر السيئة إذا طردها جاءت ومرت لكن هذا عازم لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان معناها أن هذا الإنسان مصمم على المعصية وعاقد العزم عليها وقلبه متجه إليها بكليته غير الشخص الذي يعي قول الله:إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ... فلا تتناقض في النصوص الشرعية.
هل يمكن أن تحجب التمني عن إنسان تقول له أنت يا فلان لا تتمن أبدا ولا تتخيل أي شيء؟ لا يمكن لأن التمني شيء من ضروريات التفكير والعقل، ولا بد منه وكل شخص يتمنى شيئا ما.
فإذا: ذكرنا تمنيات أهل الفسق والفجور فما هي تمنيات أهل الصلاح؟ ذكرنا بعض التمنيات التي تصرف الإنسان عن الله في الأثمان والنسوان والسلطان الخ.
فما هي تمنيات أصحاب الهمة العالية؟ مثلا: رجل يتمنى أن يحفظ صحيح البخاري أو يحفظ القرآن قبل ذلك ويتمنى أن يكون قد قرأ كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري ويتمنى أنه قد درس عند الشيخ الفلاني أو يتمنى أنه كان في روابي أرض الجهاد فيجاهد في سبيل الله يتمنى الخير ويقول: لو أن لي مالا لعملت به بعمل فلان من الأتقياء يتقي فيه ربه ويخرج حقه ويصل رحمه.
هذا التمني هو الذي ينبغي أن يكون في نفس المؤمن هذه الأمنيات ينبغي أن تكون موجودة في القلب وهي ليست مهلكة ولا آثمة وإنما هي أماني المؤمن ولكل إنسان أمانيه فما هي أمنيتك أيها المسلم؟ إن العصاة يتمنون أن يعصوا الله بأموالهم وصاحب الدنيا يتمنى سيارة فارهة وبيتا من عدة أدوار وسلطان وأهل الآخرة أمنياتهم تختلف عن أهل الفسق تمام الاختلاف.
ثانيا: التمني
فإنه من مفسدات القلب وهو بحر لا ساحل له يركبه مفاليس العالم والمنى رأس أموال المفاليس والمفلس هو الذي ليس عنده أعمال صالحة أو ليس عنده عطاء لهذا الدين ماذا يفعل لكي ينجو من لوم النفس إذا لامته، أو ينجو من تأنيب الضمير إذا أنبه؟
يعلق النفس بالأماني ويقول: سيغفر الله لي أليس الله بغفور رحيم! فلا تزال أمواج الأماني الكاذبة تتلاعب براكب بحر التمني وكل حسب حاجته فمنهم من يعتمد على رحمة الله ويعصي ويحلم بالأماني ويحلم بجنة عرضها السماوات والأرض ولكن لا يفكر في أنها أعدت للمتقين هؤلاء المتكلون على رحمة الله مما ضيعهم مسألة مهمة جدا ما هي؟ إذا تأملت حالهم وجدتهم ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم هذه عبارة مهمة جدا ذكرها علماؤنا ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم هؤلاء أصحاب الأماني ما هي مشكلتهم ومصيبتهم؟
إنهم ينظرون في حقهم على الله فيقولون: لا بد أن الله يغفر لنا فنحن موحدون ونحن مسلمون قلنا: لا إله إلا الله، أليس من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة؟ أليس؟ أليس؟ أكيد أن الله سيغفر لنا فينظرون في حقهم على الله والآن كل تفكيرهم وجل همهم ماذا سيفعل الله لهم من أنواع النعيم المقيم وجنات النعيم، ولكنهم لا يفكرون في حق الله عليهم، لو فكروا في حق الله عليهم وأنهم ينبغي أن يعبدوه وأن يصلحوا شأنهم معه؛ لعرفوا تقصيرهم، ولعرفوا أنهم مهما قدموا من الصالحات فلا يزالون مقصرين، إلا إذا تداركهم الله برحمته و (لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته).
فإذا: هذا التمني من الدواهي التي تصيب القلب فتهلكه لأن الإنسان لا يزال في أحلام وتخيلات في أنواع الجزاء الذي سيأخذه يوم القيامة وهو قد نأى بنفسه عن التفكير في حق الله عليه.
ومن الناس من يجعل تمنياته في القدرة والسلطان فيحلم وينظر إلى المستقبل أو ينظر إلى نفسه يتمنى أن يكون أميرا أو كبيرا أو وزيرا أو رئيسا أو زعيما أو مديرا أو نائب مدير أو نائب المدير العام ونحو ذلك من الأشياء.
ومنهم من أمانيه في الضرب في الأرض والتطواف في البلدان في السياحات ورؤية البلدان والمناظر الخلابة إلخ.
وهذا أمانيه محصورة بهذا الجانب ومنهم أناس من أمنياتهم أو أمانيهم في الأموال والأثمان تاجر وربح وكسب وتضاعف رأس ماله ولا خسارة تذكر وهكذا وتوسعت الشركات وفتحت الفروع وعملت الأعمال وهكذا فهو محصور في عملية الأثمان والأموال والتجارات وكل متمن بحسبه.
ومشكلة التمني أنه يصور الأمر لهذا المتمني أنه قد فاز بمطلوبه لأنه عندما يفكر أنه قد وصل وأنه حصل على هذه الأشياء وهذا مجرد تفكير وخيالات يرتاح فيها مؤقتا ويلتذ لذة وهمية لأنه لم يحصل له شيء من هذا، وإنما هي أمنيات فبينما هو على هذه الحال إذا استيقظ فوجد الحصير في يده ليس عنده إلا الحصير.
فلابد أن نقف وقفة بسيطة نقول: هل خطأ أن الإنسان يتمنى مالا أو غنى أو جاها هل هذا خطأ في الشرع نقول: لا.
لكن الخطأ ورد في حديث مهم جدا ذكره عليه الصلاة والسلام: ذكر أربعة من الرجال وذكر أحوالهم فكان مما قاله في أحد الأحاديث: (ورجل يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان) إنسان غني يعمل صالحات وينفق أموالا وزكوات وصدقات وكفالة أيتام ويبني المساجد ويعمل الملاجئ والأوقاف وآخر يقول: لو أن لي مال فلان لعملت بعمله وكلمة لو أن لي مال فلان تعتبر تمنيا وهذا هو التمني المحمود لأنه يتمنى لو أن له مال فلان لعمل فيه بعمل فلان أي لتصدق وزكى وأنفق وبنى المساجد وكفل الأيتام وتصدق على الفقراء وأخرج المجاهدين وعمل أوقافا إلى آخره، وطبع الكتب، ودعم الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية وعمل مراكز ربما في الخارج وأنفق على دعاة وجعل رواتب للدعاة لكي يتفرغوا للدعوة وفكر في أشياء هذا الإنسان يؤجر على أمنيته يؤجر على نيته الطيبة ولو ما عنده مال يقول عليه الصلاة والسلام: (فهما في الأجر سواء).
وآخر عنده مال عمل فيه بمعصية الله سافر السفريات المحرمة وأنفق الأموال على أهل الفواحش وأرباب الفسق وقرناء السوء وظلم في هذه المال وقطع رحما ومنع زكاة ولم يكن من المصلين ولم يحض على طعام المسكين ونهر السائل وقهر اليتيم الخ.
هذا إنسان آثم ولا شك وشخص آخر يقول: لو أن لي مال فلان لعملت بعمله لو أن لي مال فلان، لركبت السيارات، ولبست الساعة الذهب الفلانية وسافرت إلى المحلات الفلانية وعملت الفواحش وعملت الموبقات ووضعت في البنك الربوي الفلاني وجاءتني الفوائد الفلانية إذا: هذا الإنسان ليس له مال لكن مجرد الأمنية هذه يأثم عليها فيقول: عليه الصلاة والسلام: (فهما في الوزر سواء) مع أنه ليس له مال ولكن تصور حتى تعلم أن القلب يعبد الله أو يعصي الله يؤجر على ما في القلب ويأثم على ما في القلب، وهذا الإثم من إنسان مريد عاقد النية، لو كان له مال فلان لعمل فيه وهذا غير الخواطر لأنه قد يقول قائل: إن الإنسان لا يأثم على الخواطر نقول: نعم.
لا يأثم على الخواطر السيئة إذا طردها جاءت ومرت لكن هذا عازم لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان معناها أن هذا الإنسان مصمم على المعصية وعاقد العزم عليها وقلبه متجه إليها بكليته غير الشخص الذي يعي قول الله:إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ... فلا تتناقض في النصوص الشرعية.
هل يمكن أن تحجب التمني عن إنسان تقول له أنت يا فلان لا تتمن أبدا ولا تتخيل أي شيء؟ لا يمكن لأن التمني شيء من ضروريات التفكير والعقل، ولا بد منه وكل شخص يتمنى شيئا ما.
فإذا: ذكرنا تمنيات أهل الفسق والفجور فما هي تمنيات أهل الصلاح؟ ذكرنا بعض التمنيات التي تصرف الإنسان عن الله في الأثمان والنسوان والسلطان الخ.
فما هي تمنيات أصحاب الهمة العالية؟ مثلا: رجل يتمنى أن يحفظ صحيح البخاري أو يحفظ القرآن قبل ذلك ويتمنى أن يكون قد قرأ كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري ويتمنى أنه قد درس عند الشيخ الفلاني أو يتمنى أنه كان في روابي أرض الجهاد فيجاهد في سبيل الله يتمنى الخير ويقول: لو أن لي مالا لعملت به بعمل فلان من الأتقياء يتقي فيه ربه ويخرج حقه ويصل رحمه.
هذا التمني هو الذي ينبغي أن يكون في نفس المؤمن هذه الأمنيات ينبغي أن تكون موجودة في القلب وهي ليست مهلكة ولا آثمة وإنما هي أماني المؤمن ولكل إنسان أمانيه فما هي أمنيتك أيها المسلم؟ إن العصاة يتمنون أن يعصوا الله بأموالهم وصاحب الدنيا يتمنى سيارة فارهة وبيتا من عدة أدوار وسلطان وأهل الآخرة أمنياتهم تختلف عن أهل الفسق تمام الاختلاف.
التعلق بغير الله
ومن الأمور التي هي من مفسدات القلب كذلك: التعلق بغير الله عز وجل.
أيها الإخوة: التعلق بغير الله له عدة نواح والكلام فيه من عدة فروع، فمن التعلق بغير الله: التعلق بالدنيا، وقد مثله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجود تمثيل في قوله عليه الصلاة والسلام: (تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش) هذا الرجل المتعلق بغير الله، فمن الناس من يتعلق بالأموال، فيعمل لها كل همه، فيخرج من الصباح ويسعى ويعمل ويكدح إلى الليل، وربما سهر إلى الساعة الثالثة في الفجر، كما قال بعضهم: امرأة تشتكي زوجها قالت: يخرج الصباح فلا يرجع إلا الساعة الثالثة في الليل، مضيع لزوجته ولأولاده ولبيته ويقول لها: هذه حياتي تريدين العيش أهلا وسهلا، لا تريدين هذا الباب مع السلامة.
فهذا الشخص عبد الدينار والدرهم، وجعل همه للدرهم والدينار، إن رضي فللمال، وإن غضب فللمال وإن سخط فللمال، وإن أعطى فللمال، وإن منع فلأجل المال، وهكذا، فجعل هذا الدرهم والدينار هو معبوده من دون الله، وهو إلهه الذي يسعى في مرضاته، والكلام في هذا الموضوع كثير، وسبق أن طرحناه عدة مرات في مجالات أوسع من هذا، ولكن هنا فقط إشارة، وهناك أناس يتعلقون مثلا بمدير أو رئيس مثلا، فيجعل هذه الرئيس إلها يعبد من دون الله، فيطيعه في معصية الله، ويجعل همه في إرضائه، ويتجنب إسخاطه بكل وسيلة ولو أسخط ربه، ويجعل هذا الرئيس إلها يعبد، ويكون هو عنده بمثابة الخادم العبد الذليل الذي يفعل له كل شيء، من أجل أن يرضيه، ولا يفكر في إرضاء ربه سبحانه وتعالى، تعس عبد هذا الرئيس.
ومن الناس من قد يتعلق أو يجعل همه إرضاء زوجته، تعس عبد الزوجة، فلو أمرته بمعصية الله أطاع، وجرته إلى مكان معصية ذهب، وهكذا من الأشياء التي قد يقع فيها بسبب إسلامه القيادة لامرأة فاسقة عاصية.
ومن التعلق بغير الله: العشق، وهذا أمر خطير جدا، قد وقع فيه كثير من الناس في القديم والحديث، وقالوا فيه الأقاويل والأشعار حتى أوضحت لنا مكنونات أولئك الناس، فإذا أردت أن تعرف عذاب العاشق في الدنيا، فإنه إنسان فان في محبة معشوقة، ومع ذلك ربما يقرب منه ويبعد عنه ذاك المعشوق ولا يفي له، ويهجره ويصل عدوه، فمعشوقه قليل الوفاء كثير الجفاء، كثير الشركاء سريع التغير، عظيم الخيانة، لا يدوم له معه وصل، فكيف إذا هجره ونأى عنه بالكلية، فإنه يكون عند ذلك جاءه العذاب الأليم، والسم الناقع، الذي يجعل حياته جحيما لا تطاق، فالمشكلة تبدأ بالتعلق، أو بالإعجاب، قد يعجب بشخص من الأشخاص، ثم يتزايد هذا الإعجاب فيقوى، حتى يصبح تعلقا بحيث إنه لا بد له من أن يلقاه في كل وقت، وفي كل حين، وأن يجلس إليه، وينظر إليه، ويسمع كلامه، ثم تتطور الأمور حتى تصبح عشقا، فيصبح متيما بهذا الشخص، همه إرضاء هذه الشخص قد غلبت محبته لهذا الشخص محبته لله عز وجل، فلذلك يعبده من دون الله ويستولي على قلبه، ويتمكن منه، فصار العاشق عابدا للمعشوق، يسعى في مرضاته ويؤثره على حب الله، بل يقدم رضاه على رضا الله، وحبه على حب الله، ويتقرب إليه ما لا يتقرب إلى الله، وينفق في مرضاة هذا المعشوق ما لا ينفق في مرضاة الله، ويتجنب في سخط هذا المعشوق ما لا يتجنبه من سخط الله، فعند ذلك يكون عبدا له بالكلية، ويكون مشركا مع الله سبحانه وتعالى.
وتأمل كيف قاد العشق امرأة العزيز إلى أن وقعت في المهاوي وعمدت إلى الفاحشة، وركبت رأسها، وغلقت الأبواب، ودعت يوسف وخانت زوجها، وأودى الأمر إلى أن يتكلم فيها نساء المدينة، ومع ذلك هي مصرة على غوايتها، وتقول: {ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين} [يوسف:32].
فإذا: أودى العشق بهذه المرأة في مهاو، والشرك قرين للعشق، والتوحيد يبعد عن العشق تماما، ولذلك كافأ الله يوسف بتوحيده لربه فأبعده عن الهلاك والرذيلة، وجعل تلك المرأة بشركها ملومة مذمومة يتكلم الناس عنها، حتى اعترفت بذنبها في النهاية، وبرأت يوسف عليه السلام.
وتكلمنا في محاضرة سابقة عن موضوع العشق لكنه -أيها الإخوة- ولم يجر عادة الكلام فيه، من شاء فليرجع إليه، لكن ينصح في هذا الموضوع بقراءة ما كتبه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وكتاب إغاثه اللهفان من مصائد الشيطان، تكلم عنه في موضع من المجلس الأول وفي المجلد الثاني ربما كان الكلام أكثر في أواخره تقريبا، فموضوع العشق هو نتيجة ضعف الإيمان، والقلوب التي لا يكون فيها إيمان مستقر، فإنه يتطرق إليها العشق، وأنتم أيها الإخوة: لو تأملتم في أكثر كلمات الأغاني لوجدتم أنها تدور على معاني العشق، وكلها صدرت من أشخاص قد جربوا العشق أو عشقوا سواء كان الملحن أو المؤلف أو المغني أو السامع، فإن غالب الكلام إذا تأملت فيه وتبصرت فعلا بنور الإيمان في كلام هؤلاء المغنين، لوجدته وصفا لأحوال العشق، وأنه قد عبر أمامه وأن قلبه قد أنشد إليه، وأنه أحسن ما في الدنيا، وأنه إذا أعطاه كلمة واحدة من الثناء، فإن له بالدنيا وما له بالدنيا وما فيها، ولذلك تقرأ حتى في بعض أشعارهم: (لو كانت ليلى في جهة المشرق، وأنا أصلي للغرب؛ لتيممت نحوها في صلاتي، ولو أنه بين الحطيم وزمزم) والكلام كله يدور على معاني العشق، وهذه الأغاني قد دمرت القلوب تدميرا، ولعله يتاح لي الفرصة للكلام على مساوئ الأغاني وترسيخ العشق في قلوب الناس السامعين، لأن بعض الناس يقول: لماذا أنتم تعقدون الأمور جدا، والأغاني ماذا فيها؟! موسيقى وكلمات، لكن صدق -بالله العظيم- أن هذه الكلمات والألحان تجر إلى الشرك بالله عز وجل، وتزين العشق للسامعين وللناس، ومن نتائج سماع الأغاني المتكررة، أن يبدأ هؤلاء السامعون للأغاني في عشق النساء والمردان وعشق الصور الجميلة -طبعا الأشخاص- المحرمة، وينبني عليها فساد عظيم في الدنيا وفي الآخرة، وينبني عليها ثوران الشهوات وينبني عليها تخريب العلاقة برب العالمين، وينبني عليها فساد العبادات، يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، الفاتحة، وقلبه متعلق بامرأة أو شخص وهكذا المسألة تسير في هذه الناحية فيجعل جل همه في إرضاء هذا المعشوق وفي طاعته، وباختصار في عبادته من دون الله.
وينبغي أيها الإخوة: أن نعلم أن العشق قد يرتبط بالمحبة، لأن العشق هو عبارة عن محبة، زادت جدا جدا حتى وصلت إلى مرحلة أنه صار متيما بهذا الأمر، وبلغ فيه النهاية القصوى، وتخلل قلبه محبة هذا المتعلق به، فينبغي أن نعلم بأن المحبة، نوعان: النوع الأول: محبة نافعة.
النوع الثاني: محبة محرمة.
فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع: النوع الأول: محبة الله وهي الأساس.
النوع الثاني: المحبة في الله، فنحن نحب الأنبياء لأي شيء؟ لصورهم وأشكالهم!! لأن الله أرسلهم، لأننا نحب الله، وهؤلاء جاءوا رسلا من الله، فنحن نحبهم لأنهم جاءوا من محبوبنا الأعظم من الله سبحانه وتعالى الذي نحبه أكثر من كل شيء، أو هكذا ينبغي أن يكون الأمر.
ثانيا: المحبة في الله.
النوع الثالث: محبة ما يعين على طاعة الله.
والمحبة السيئة ثلاثة أنواع: النوع الأول: محبة مع الله، هذا شرك: {ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله} [البقرة:165] وهذا يقع فيه العاشقون، يقعون في هذا النوع من الشرك وهو المحبة مع الله، فهذا من أحسن أحوال بعضهم، وإلا فإن بعضهم نسي الله عز وجل تماما، وصار كل همه في محبة المعشوق محبة مع الله.
النوع الثاني: محبة ما يبغضه الله، وهي مذمومة أيضا.
النوع الثالث: محبة ما يقطع عن الله، إذا كان محبتك لشيء تقطعك عن الله، فمحبتك لهذا الشيء حرام، إذا كان التلفزيون يقطعك عن الله، فمحبتك له حرام، إذا كانت الألعاب -أي لعبة لو كانت مباحة- فلو قال قائل: المحبة مع الله شرك عرفناه، محبة ما يبغضه الله عرفناها، ولو كانت أفلاما محرمة، أو أغاني إلى آخره عرفنا أنها محرمة وأن محبتها محرمة وأن الله عز وجل يبغضها وأن محبة ما يبغضه الله حرام، لكن ما معنى محبة ما يقطع عن الله؟ يعني: أن هناك أشياء مباحة أصلا لا يبغضها الله، لكن إذا كانت محبتك لها تقطعك عن الله، فينبغي أن تبغضها، ولا تحب الأشياء التي تقطعك عن الله ولو كانت مباحة مادامت تقطعك عن الله مثلا: إنسان محبته لزوجته تمنعه من الخروج إلى صلاة الفجر، ما حكم محبة الزوجة؟ مباح، بل شيء طيب، بل لا يمكن أن تستقيم الأسرة إلا إذا أحب الرجل زوجته والعكس، لكن لو أن هذه المحبة صارت إلى درجة أن الرجل من تعلقه بزوجته صار لا يمكن أن يفارقها، لإجابة نداء المؤذن في صلاة الفجر، فماذا يكون الحكم؟ هنا صار الأمر محرما، لأن هذه المحبة في هذا الأمر قد قطعته عما يحبه الله، فصار تعطيلا عن العبادة ومنعا من أدائها، وصار أمرا لا يجوز، وقد أجاب ابن القيم رحمه الله في موضوع العشق في إغاثة اللهفان عن مسألة قال: ما حكم عشق الرجل لزوجته؟ فقال: إنه جائز إلا إذا كان يشغل عن عبادة الله.
لا يمانع أن الإنسان يحب زوجته جدا، بشرط ألا يقع في الشرك لكن إذا وصل الأمر إلى أنها توقعه في معصية وتصرفه عن طاعة، فعند ذلك يصبح أمرا محرما.
ومحبة الصور المحرمة وعشقها من موجبات الشرك، وكلما كان العبد أقرب إلى الشرك، كان عشقه للصور أوقع وأكثر في نفسه.
كثرة الطعام
ومن مفسدات القلب أيها الإخوة: كثرة الطعام، وكثرة الطعام على نوعين: شيء من المحرمات، أو من المباحات، فإذا كان محرما كالميتة، والدم والخنزير والخمر والشيء المغصوب والمسروق فإن أكله حرام، ولا يجوز فهو يفسد القلب بالتأكيد.
وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، وإذا كان يأكل من الربا ويتغذى على الربا، فهل سيكون قلبه يقظا؟ بالتأكيد لا.
الشيء الثاني: أطعمة مباحة، لكن الإنسان أسرف وجاوز الحد في المباح، والمباحات لها حدود فإذا جاوزت الحد في المباح تقع في المحذور، فالإسراف في الحلال في هذه المطعومات يؤدي إلى الشبع المفرط، والشبع المفرط يشغل عن الطاعة، وذلك لأنه يسبب بطنة، ومحالة إزالتها أو الوقاية من أمراضها، فيكون شيئا مذموما، ثم إن الشبع التام يقوي الشهوة، ويوسع مجاري الشيطان ومن أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا، ولا يمكن أن نقارن بين التوسع في الحلال وبين الأكل الحرام، لكن أيهما أعظم؟ الأصل أن الأكل من الحرام أعظم، والتوسع في المباح يصير مذموما إذا شغل عن عبادة الله عز وجل، ودعوني أقول لكم فائدة ذكرتها الآن: جاءني سؤال في ذات مرة، قال: رجل يأكل ثم يذهب ويستفرغ، ثم يعود يأكل ثم يذهب ويستفرغ، لماذا؟ قال: لأن هذا الإنسان يحب الطعام جدا، ولا يمكن أنه لا يأكل، أو يتلذذ بالطعام، ولكنه في نفس الوقت لا يريد زيادة وزنه فكيف يجمع بين الأمرين؟ فصار هذا المسكين يأكل ويتلذذ بالطعام، ثم يذهب إلى دورة المياه ويتقيأ ويتقيأ، ثم يعود مرة أخرى، فسألت الشيخ عبد العزيز حفظه الله عن هذا الموضوع قال: لا أدري ما هذا؟ عبث وأقل أحواله الكراهية الشديدة، لأنه إنسان متلف للمال على غير شيء، يأكل ويذهب ويستفرغ، فصارت المسألة كأنها حياة البهائم.
كثرة النوم
والمسالة الخامسة من مفسدات القلب كثرة النوم، فإن كثرة النوم، تميت القلب، وتثقل البدن، ومضيعة للأوقات، وسبب في الغفلة والكسل، وهناك نوم نافع، كالقيلولة وأول الليل وسدسه الأخير، ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه، أي: قبل الظهر أو بعد الظهر أنفع من طرفيه، وكلما قرب النوم من طرفي النهار زاد ضرره وقل نفعه، إلا المحتاج، فلو نمت مثلا في أول النهار وقت تنزل البركات (بورك لأمتي في بكورها) ونوم بعد الفجر عند السلف مذموم؛ لأن هذا وقت تقسم فيه الأرزاق، وتحل فيه البركة، وتتنزل فيه ملائكة الرحمن، فيكون من حرمان الخير النوم فيه إلا المحتاج، وكذلك النوم بين المغرب والعشاء، وهذا أسوء الأشياء ولذلك نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهيا صريحا، نهى عن النوم قبل العشاء، ولا ينام الإنسان قبل العشاء، النوم بعد المغرب منهي عنه، وهذا أسوء أنواع النوم، والنوم بعد العصر أيضا فيه نوع من الضرب، ولكن إلا للمحتاج، لأن طبيعة العمل تحيج الإنسان لهذا، ولقد صار الناس نتيجة الورديات والأعمال وتطلب الإنتاج الكبير يشتغل في المصنع أربعا وعشرين ساعة، حتى يكون إنتاجه أكثر فلما جعلنا همنا للدنيا، صار الناس حياتهم في جحيم، فيقول لك: أنا ليلي نهار، ونهاري ليل، منقلب وأريد أن أبدل وأسير على غير هذا إلا أن المجتمع صار هكذا، كل الأشياء مبنية على الدنيا.
ومن الأمور التي هي من مفسدات القلب كذلك: التعلق بغير الله عز وجل.
أيها الإخوة: التعلق بغير الله له عدة نواح والكلام فيه من عدة فروع، فمن التعلق بغير الله: التعلق بالدنيا، وقد مثله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجود تمثيل في قوله عليه الصلاة والسلام: (تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش) هذا الرجل المتعلق بغير الله، فمن الناس من يتعلق بالأموال، فيعمل لها كل همه، فيخرج من الصباح ويسعى ويعمل ويكدح إلى الليل، وربما سهر إلى الساعة الثالثة في الفجر، كما قال بعضهم: امرأة تشتكي زوجها قالت: يخرج الصباح فلا يرجع إلا الساعة الثالثة في الليل، مضيع لزوجته ولأولاده ولبيته ويقول لها: هذه حياتي تريدين العيش أهلا وسهلا، لا تريدين هذا الباب مع السلامة.
فهذا الشخص عبد الدينار والدرهم، وجعل همه للدرهم والدينار، إن رضي فللمال، وإن غضب فللمال وإن سخط فللمال، وإن أعطى فللمال، وإن منع فلأجل المال، وهكذا، فجعل هذا الدرهم والدينار هو معبوده من دون الله، وهو إلهه الذي يسعى في مرضاته، والكلام في هذا الموضوع كثير، وسبق أن طرحناه عدة مرات في مجالات أوسع من هذا، ولكن هنا فقط إشارة، وهناك أناس يتعلقون مثلا بمدير أو رئيس مثلا، فيجعل هذه الرئيس إلها يعبد من دون الله، فيطيعه في معصية الله، ويجعل همه في إرضائه، ويتجنب إسخاطه بكل وسيلة ولو أسخط ربه، ويجعل هذا الرئيس إلها يعبد، ويكون هو عنده بمثابة الخادم العبد الذليل الذي يفعل له كل شيء، من أجل أن يرضيه، ولا يفكر في إرضاء ربه سبحانه وتعالى، تعس عبد هذا الرئيس.
ومن الناس من قد يتعلق أو يجعل همه إرضاء زوجته، تعس عبد الزوجة، فلو أمرته بمعصية الله أطاع، وجرته إلى مكان معصية ذهب، وهكذا من الأشياء التي قد يقع فيها بسبب إسلامه القيادة لامرأة فاسقة عاصية.
ومن التعلق بغير الله: العشق، وهذا أمر خطير جدا، قد وقع فيه كثير من الناس في القديم والحديث، وقالوا فيه الأقاويل والأشعار حتى أوضحت لنا مكنونات أولئك الناس، فإذا أردت أن تعرف عذاب العاشق في الدنيا، فإنه إنسان فان في محبة معشوقة، ومع ذلك ربما يقرب منه ويبعد عنه ذاك المعشوق ولا يفي له، ويهجره ويصل عدوه، فمعشوقه قليل الوفاء كثير الجفاء، كثير الشركاء سريع التغير، عظيم الخيانة، لا يدوم له معه وصل، فكيف إذا هجره ونأى عنه بالكلية، فإنه يكون عند ذلك جاءه العذاب الأليم، والسم الناقع، الذي يجعل حياته جحيما لا تطاق، فالمشكلة تبدأ بالتعلق، أو بالإعجاب، قد يعجب بشخص من الأشخاص، ثم يتزايد هذا الإعجاب فيقوى، حتى يصبح تعلقا بحيث إنه لا بد له من أن يلقاه في كل وقت، وفي كل حين، وأن يجلس إليه، وينظر إليه، ويسمع كلامه، ثم تتطور الأمور حتى تصبح عشقا، فيصبح متيما بهذا الشخص، همه إرضاء هذه الشخص قد غلبت محبته لهذا الشخص محبته لله عز وجل، فلذلك يعبده من دون الله ويستولي على قلبه، ويتمكن منه، فصار العاشق عابدا للمعشوق، يسعى في مرضاته ويؤثره على حب الله، بل يقدم رضاه على رضا الله، وحبه على حب الله، ويتقرب إليه ما لا يتقرب إلى الله، وينفق في مرضاة هذا المعشوق ما لا ينفق في مرضاة الله، ويتجنب في سخط هذا المعشوق ما لا يتجنبه من سخط الله، فعند ذلك يكون عبدا له بالكلية، ويكون مشركا مع الله سبحانه وتعالى.
وتأمل كيف قاد العشق امرأة العزيز إلى أن وقعت في المهاوي وعمدت إلى الفاحشة، وركبت رأسها، وغلقت الأبواب، ودعت يوسف وخانت زوجها، وأودى الأمر إلى أن يتكلم فيها نساء المدينة، ومع ذلك هي مصرة على غوايتها، وتقول: {ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين} [يوسف:32].
فإذا: أودى العشق بهذه المرأة في مهاو، والشرك قرين للعشق، والتوحيد يبعد عن العشق تماما، ولذلك كافأ الله يوسف بتوحيده لربه فأبعده عن الهلاك والرذيلة، وجعل تلك المرأة بشركها ملومة مذمومة يتكلم الناس عنها، حتى اعترفت بذنبها في النهاية، وبرأت يوسف عليه السلام.
وتكلمنا في محاضرة سابقة عن موضوع العشق لكنه -أيها الإخوة- ولم يجر عادة الكلام فيه، من شاء فليرجع إليه، لكن ينصح في هذا الموضوع بقراءة ما كتبه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وكتاب إغاثه اللهفان من مصائد الشيطان، تكلم عنه في موضع من المجلس الأول وفي المجلد الثاني ربما كان الكلام أكثر في أواخره تقريبا، فموضوع العشق هو نتيجة ضعف الإيمان، والقلوب التي لا يكون فيها إيمان مستقر، فإنه يتطرق إليها العشق، وأنتم أيها الإخوة: لو تأملتم في أكثر كلمات الأغاني لوجدتم أنها تدور على معاني العشق، وكلها صدرت من أشخاص قد جربوا العشق أو عشقوا سواء كان الملحن أو المؤلف أو المغني أو السامع، فإن غالب الكلام إذا تأملت فيه وتبصرت فعلا بنور الإيمان في كلام هؤلاء المغنين، لوجدته وصفا لأحوال العشق، وأنه قد عبر أمامه وأن قلبه قد أنشد إليه، وأنه أحسن ما في الدنيا، وأنه إذا أعطاه كلمة واحدة من الثناء، فإن له بالدنيا وما له بالدنيا وما فيها، ولذلك تقرأ حتى في بعض أشعارهم: (لو كانت ليلى في جهة المشرق، وأنا أصلي للغرب؛ لتيممت نحوها في صلاتي، ولو أنه بين الحطيم وزمزم) والكلام كله يدور على معاني العشق، وهذه الأغاني قد دمرت القلوب تدميرا، ولعله يتاح لي الفرصة للكلام على مساوئ الأغاني وترسيخ العشق في قلوب الناس السامعين، لأن بعض الناس يقول: لماذا أنتم تعقدون الأمور جدا، والأغاني ماذا فيها؟! موسيقى وكلمات، لكن صدق -بالله العظيم- أن هذه الكلمات والألحان تجر إلى الشرك بالله عز وجل، وتزين العشق للسامعين وللناس، ومن نتائج سماع الأغاني المتكررة، أن يبدأ هؤلاء السامعون للأغاني في عشق النساء والمردان وعشق الصور الجميلة -طبعا الأشخاص- المحرمة، وينبني عليها فساد عظيم في الدنيا وفي الآخرة، وينبني عليها ثوران الشهوات وينبني عليها تخريب العلاقة برب العالمين، وينبني عليها فساد العبادات، يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، الفاتحة، وقلبه متعلق بامرأة أو شخص وهكذا المسألة تسير في هذه الناحية فيجعل جل همه في إرضاء هذا المعشوق وفي طاعته، وباختصار في عبادته من دون الله.
وينبغي أيها الإخوة: أن نعلم أن العشق قد يرتبط بالمحبة، لأن العشق هو عبارة عن محبة، زادت جدا جدا حتى وصلت إلى مرحلة أنه صار متيما بهذا الأمر، وبلغ فيه النهاية القصوى، وتخلل قلبه محبة هذا المتعلق به، فينبغي أن نعلم بأن المحبة، نوعان: النوع الأول: محبة نافعة.
النوع الثاني: محبة محرمة.
فالمحبة النافعة ثلاثة أنواع: النوع الأول: محبة الله وهي الأساس.
النوع الثاني: المحبة في الله، فنحن نحب الأنبياء لأي شيء؟ لصورهم وأشكالهم!! لأن الله أرسلهم، لأننا نحب الله، وهؤلاء جاءوا رسلا من الله، فنحن نحبهم لأنهم جاءوا من محبوبنا الأعظم من الله سبحانه وتعالى الذي نحبه أكثر من كل شيء، أو هكذا ينبغي أن يكون الأمر.
ثانيا: المحبة في الله.
النوع الثالث: محبة ما يعين على طاعة الله.
والمحبة السيئة ثلاثة أنواع: النوع الأول: محبة مع الله، هذا شرك: {ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله} [البقرة:165] وهذا يقع فيه العاشقون، يقعون في هذا النوع من الشرك وهو المحبة مع الله، فهذا من أحسن أحوال بعضهم، وإلا فإن بعضهم نسي الله عز وجل تماما، وصار كل همه في محبة المعشوق محبة مع الله.
النوع الثاني: محبة ما يبغضه الله، وهي مذمومة أيضا.
النوع الثالث: محبة ما يقطع عن الله، إذا كان محبتك لشيء تقطعك عن الله، فمحبتك لهذا الشيء حرام، إذا كان التلفزيون يقطعك عن الله، فمحبتك له حرام، إذا كانت الألعاب -أي لعبة لو كانت مباحة- فلو قال قائل: المحبة مع الله شرك عرفناه، محبة ما يبغضه الله عرفناها، ولو كانت أفلاما محرمة، أو أغاني إلى آخره عرفنا أنها محرمة وأن محبتها محرمة وأن الله عز وجل يبغضها وأن محبة ما يبغضه الله حرام، لكن ما معنى محبة ما يقطع عن الله؟ يعني: أن هناك أشياء مباحة أصلا لا يبغضها الله، لكن إذا كانت محبتك لها تقطعك عن الله، فينبغي أن تبغضها، ولا تحب الأشياء التي تقطعك عن الله ولو كانت مباحة مادامت تقطعك عن الله مثلا: إنسان محبته لزوجته تمنعه من الخروج إلى صلاة الفجر، ما حكم محبة الزوجة؟ مباح، بل شيء طيب، بل لا يمكن أن تستقيم الأسرة إلا إذا أحب الرجل زوجته والعكس، لكن لو أن هذه المحبة صارت إلى درجة أن الرجل من تعلقه بزوجته صار لا يمكن أن يفارقها، لإجابة نداء المؤذن في صلاة الفجر، فماذا يكون الحكم؟ هنا صار الأمر محرما، لأن هذه المحبة في هذا الأمر قد قطعته عما يحبه الله، فصار تعطيلا عن العبادة ومنعا من أدائها، وصار أمرا لا يجوز، وقد أجاب ابن القيم رحمه الله في موضوع العشق في إغاثة اللهفان عن مسألة قال: ما حكم عشق الرجل لزوجته؟ فقال: إنه جائز إلا إذا كان يشغل عن عبادة الله.
لا يمانع أن الإنسان يحب زوجته جدا، بشرط ألا يقع في الشرك لكن إذا وصل الأمر إلى أنها توقعه في معصية وتصرفه عن طاعة، فعند ذلك يصبح أمرا محرما.
ومحبة الصور المحرمة وعشقها من موجبات الشرك، وكلما كان العبد أقرب إلى الشرك، كان عشقه للصور أوقع وأكثر في نفسه.
كثرة الطعام
ومن مفسدات القلب أيها الإخوة: كثرة الطعام، وكثرة الطعام على نوعين: شيء من المحرمات، أو من المباحات، فإذا كان محرما كالميتة، والدم والخنزير والخمر والشيء المغصوب والمسروق فإن أكله حرام، ولا يجوز فهو يفسد القلب بالتأكيد.
وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، وإذا كان يأكل من الربا ويتغذى على الربا، فهل سيكون قلبه يقظا؟ بالتأكيد لا.
الشيء الثاني: أطعمة مباحة، لكن الإنسان أسرف وجاوز الحد في المباح، والمباحات لها حدود فإذا جاوزت الحد في المباح تقع في المحذور، فالإسراف في الحلال في هذه المطعومات يؤدي إلى الشبع المفرط، والشبع المفرط يشغل عن الطاعة، وذلك لأنه يسبب بطنة، ومحالة إزالتها أو الوقاية من أمراضها، فيكون شيئا مذموما، ثم إن الشبع التام يقوي الشهوة، ويوسع مجاري الشيطان ومن أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا، ولا يمكن أن نقارن بين التوسع في الحلال وبين الأكل الحرام، لكن أيهما أعظم؟ الأصل أن الأكل من الحرام أعظم، والتوسع في المباح يصير مذموما إذا شغل عن عبادة الله عز وجل، ودعوني أقول لكم فائدة ذكرتها الآن: جاءني سؤال في ذات مرة، قال: رجل يأكل ثم يذهب ويستفرغ، ثم يعود يأكل ثم يذهب ويستفرغ، لماذا؟ قال: لأن هذا الإنسان يحب الطعام جدا، ولا يمكن أنه لا يأكل، أو يتلذذ بالطعام، ولكنه في نفس الوقت لا يريد زيادة وزنه فكيف يجمع بين الأمرين؟ فصار هذا المسكين يأكل ويتلذذ بالطعام، ثم يذهب إلى دورة المياه ويتقيأ ويتقيأ، ثم يعود مرة أخرى، فسألت الشيخ عبد العزيز حفظه الله عن هذا الموضوع قال: لا أدري ما هذا؟ عبث وأقل أحواله الكراهية الشديدة، لأنه إنسان متلف للمال على غير شيء، يأكل ويذهب ويستفرغ، فصارت المسألة كأنها حياة البهائم.
كثرة النوم
والمسالة الخامسة من مفسدات القلب كثرة النوم، فإن كثرة النوم، تميت القلب، وتثقل البدن، ومضيعة للأوقات، وسبب في الغفلة والكسل، وهناك نوم نافع، كالقيلولة وأول الليل وسدسه الأخير، ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه، أي: قبل الظهر أو بعد الظهر أنفع من طرفيه، وكلما قرب النوم من طرفي النهار زاد ضرره وقل نفعه، إلا المحتاج، فلو نمت مثلا في أول النهار وقت تنزل البركات (بورك لأمتي في بكورها) ونوم بعد الفجر عند السلف مذموم؛ لأن هذا وقت تقسم فيه الأرزاق، وتحل فيه البركة، وتتنزل فيه ملائكة الرحمن، فيكون من حرمان الخير النوم فيه إلا المحتاج، وكذلك النوم بين المغرب والعشاء، وهذا أسوء الأشياء ولذلك نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهيا صريحا، نهى عن النوم قبل العشاء، ولا ينام الإنسان قبل العشاء، النوم بعد المغرب منهي عنه، وهذا أسوء أنواع النوم، والنوم بعد العصر أيضا فيه نوع من الضرب، ولكن إلا للمحتاج، لأن طبيعة العمل تحيج الإنسان لهذا، ولقد صار الناس نتيجة الورديات والأعمال وتطلب الإنتاج الكبير يشتغل في المصنع أربعا وعشرين ساعة، حتى يكون إنتاجه أكثر فلما جعلنا همنا للدنيا، صار الناس حياتهم في جحيم، فيقول لك: أنا ليلي نهار، ونهاري ليل، منقلب وأريد أن أبدل وأسير على غير هذا إلا أن المجتمع صار هكذا، كل الأشياء مبنية على الدنيا.
الذنوب والمعاصي
ومن الأشياء التي تفسد القلب: الذنوب، ومن الأدلة على ذلك ما قاله ذلك الرجل الصالح:
رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها
ومن الأشياء التي تفسد القلب: الذنوب، ومن الأدلة على ذلك ما قاله ذلك الرجل الصالح:
رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها
وكما جعلت حياة البدن بالطعام والشراب، فحياة القلب بدوام ذكر الله والإنابة إليه، وترك الذنوب، وإذا زادت الذنوب علا الران على القلب، حتى يتغلف ولذلك قال بعض السلف: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: الموطن الأول: عند سماع القرآن.
الموطن الثاني: في مجال الذكر.
الموطن الثالث: في أوقات الخلوة.
فإن لم تجده في هذه المواطن، فاسأل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك.
الخواطر السيئة والاسترسال فيها
ومن الأمور التي تفسد القلب أيضا: الخواطر السيئة والاسترسال فيها، وقد ذكرنا قبل قليل أن مجرد مرور الخاطر لا يمكن للإنسان أن يدفعه بل لابد أن يخطر ببالك شيء، لكن الخطر عندما تسترسل في الخواطر السيئة وتتمادى فيها، فإن مبدأ كل عمل خواطر وأفكار، الخاطرة تصبح فكرة، والفكرة تصبح تصورا، والتصورات تدعو للإرادة، والإرادة تقتضي وقوع الفعل، وإذا وقع الفعل بكثرة وتكرر وصار عادة، فأنى لهم بعد ذلك أن يغيروا.
فإذا: متى تصلح أعمالك؟ إذا صلحت خواطرك التي تخطر في قلبك ونفسك، وصارت خواطر طيبة، وإذا صارت الخواطر السيئة دائما تخطر ببال الإنسان كالفواحش والحرام، والكسب المحرم، ويخطر بباله الظلم وأنه يريد أن يبطش.
إذا كثرت الخواطر السيئة والإنسان لم يدافعها ولا استعاذ بالله منها، واسترسل فيها وتمادى، تتحول إلى ملكات في النفس راسخة، ثم تضغط على الجوارح حتى تصبح فعلا، فيفعل ما خطر بباله من المحرمات، والإنسان لا يمكنه منع نفسه من الخواطر، إلا أن قوة الإيمان تعين على دفع الخواطر الرذيلة.
انظر إلى حال الصحابة، يعني: أحيانا تأتي لأحدهم الخواطر في ذات الله سبحانه وتعالى، (قالوا: يا رسول الله! إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن يحترق حتى يصير حمما، أحب إليه من أن يتكلم به) تأتينا أحيانا خواطر في ذات الله، لو أني ترديت من جبل أو احترقت حتى صرت فحما ولا أن أتكلم به، فقال عليه الصلاة والسلام: (الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ذاك صريح الإيمان) يعني: إذا أنت توصلت إلى التحرج من هذه الخواطر لدرجة أنك تتردى من جبل، وتهلك وتحترق ولا تتكلم بها معناه أنك إنسان عندك إيمان قوي، ولذلك خنس الشيطان في نفسك ولم يقدر عليك إلا بهذه الخواطر تكرهها وتدافعها ما استطعت، والله سبحانه وتعالى خلق النفس شبيهة الرحى، ما هو الرحى؟ آلة الطحن، ولا تسكن، خلق النفس شبيهة بالرحى لا تسكن، هذا تمثيل جيد، ذكره ابن القيم رحمه الله وهذه الرحى التي لا تسكن لا بد لها من حب تطحنه، فإذا طحنت حبا خرج دقيقا جديدا، كان الحب قمحا فخرج طحينا جيدا، وإذا كان ترابا وحصى ماذا يخرج الطحن؟ وإذا كان في الطاحون شيء من القمح، ثم جاء إنسان بسطل من التبن وفتح الطاحون ووضعه فيه، فماذا سيحدث؟ يختلط الطيب والرديء، فانظر في نفسك ما هي الأفكار التي تدور فيها؟ فإذا كان ما يدور في نفسك قمحا جيدا ستكون النتيجة عملا جيدا، ودقيقا نافعا.
وإذا كانت الخواطر التي تدور في نفسك خواطر سوء معناها أن النتيجة التي ستخرج بعد الطحن ستكون أعمالا سيئة، وإذا كان مخلوط بينهما، يخرج لك مثل الدقيق المخلوط بالتبن والعلف وهذا حال النفس وما يأتي فيها من الخواطر الطيبة والرديئة.
حب الرئاسة
بقي لنا أيها الإخوة من الكلام في هذا لموضوع نقطتان: الأولى: تتعلق بحب الرئاسة، والثانية: تتعلق بالرياء، ثم الإجابة عن بعض الأسئلة.
أما بالنسبة لحب الرئاسة فإن حب الرئاسة شهوة خفية في النفس، وطمع يسعى إليه كل من في قلبه شيء من محبة هذه الأمور، فإن أكثر الناس يحب أن يكون ظاهرا ومعظما، رئيسا مطاعا وإليه الأمر في الأمور، وأن يؤخذ برأيه ومشورته، ونحو ذلك.
ونظرا لأن حب الرئاسة أو لأن الرئاسة إذا حصلت، يقع كثير من الناس بسببها في الظلم وفساد النية؛ لأن أصحاب المراكز دائما الأنظار والأضواء مسلطة عليهم، جاء فلان وحضر فلان، فيقع في نفس الشخص شيء من كثرة ذكره بين الناس، وأنه شخص مهم، وبالتالي يقع فساد في قلبه من جراء هذا الأمر خصوصا إذا بدأ الناس يتزلفون إليه، وقد يصرفون إليه شيئا من الأشياء التي لا تجوز إلا لله، من أجل أن يحصلوا على مكاسب من ورائه فيتخذونه سلما ويصرفون إليه أشياء من هذه الأمور التي فيها معاني العبودية، نظرا لذلك كانت الرئاسة مسألة خطيرة، وكان للسلف مواقف منها، وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه واحد يطلب إمارة لم يعطه، قال: (إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله) جاء واحد يسأل الإمارة فقال: (يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها -أي أعطيت لك- أوكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها) لو أعطيتها من غير مسألة وقيل لك: تول قلت: لا أريد، ثم ألزموك بها، فسيعينونك رغما عنهم؛ لأنهم هم الذين ورطوك في الأمر وأنت كاره له، فلا بد أن يعينوك، وإلا فلا تقبل بهذه، ولأن الرئاسة أو الإمارة فيها إفساد للقلب، ابتعد عنها كثير من السلف، وكانوا يتعوذون بالله منها كما يتعوذون من الشيطان، وهذا الذي يفسر لنا عزوف بعض السلف عن القضاء، يخشى من المنصب، ويخشى أن يظلم الناس بسببه، وكان ربما ضرب بعضهم وسجن ليتولى القضاء ويرفض ذلك.
فإن قال قائل، لكن الناس لا بد لهم من رؤساء، ولا بد لهم من قواد، فكيف نفعل؟ فنقول: في الوضع الإسلامي والجو الإسلامي، عندنا نماذج ما حدث في عهد أبي بكر وعمر، وقول أبي بكر لما بويع، طلب من الناس إذا وجدوه على خير أن يعينوه وإذا وجدوه على باطل أن ينقدوه ويصوبوه، وكان عمر دقيقا في محاسبة الولاة، وكان يعزل ويولي على أشياء بالدقة والإتقان، ويجعل العيون على الولاة، وكانت تأتي إليه أخبارهم بالدقة دائما وهذا في عهد السلف ولا بد أن نفهم هذه القضية، في عهد السلف كان الأكفاء وأهل العلم كثر، إذا تدافعوا القضاء سيتولى واحد من أهل العلم، لأن أهل العلم كثر، وكذلك إذا ولي فلان ولايات، هناك من الأكفاء وأهل الطاعة والإيمان والقدرة كثر، إنه مجتمع إسلامي ناضج وفيه خبرات متفتحة، فلما تدافعوا كان تدافعهم من أجل أنه وجد أكفاء يديرون الأمور، فلو دفع عن نفسه؛ لا يحصل بسبب ذلك ضرر على المجتمع، لكن نحن الآن في وضعنا ماذا نفعل، تعالوا ننظر في حال يوسف عليه السلام {اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم} [يوسف:55] لماذا طلب يوسف المنصب؟ وكيف يطلب يوسف المنصب؟ ونحن نتكلم الآن عن حب الرئاسة، نقول: إن يوسف كان يعلم، ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه، أنه كان لديه خبرة وقدرة على إدارة أمور التخزين، والصرف للناس بشيء من القدرة التي أعطاه الله إياها، ولم يكن يوجد في البلاد مثله ولا قريبا منه، فلأجل صالح الناس العام طلب أن يتولى ذلك المنصب، ولذلك نقول: إذا قل الأكفاء، فلا بد أن يولى الأكفاء وإذا ولي الأكفاء، فلا بد أن يربوا لأنه لو لم يتول هذا المنصب، لجاء آخر فأفسد فيه، لكن لو وجد من يتولى المنصب مثله في الكفاءة، أو قريبا منه، فالأسلم للقلب في هذه الحالة أن يبتعد عن المنصب، فلو كان يشغل المنصب عندنا فاسق وإنسان متمسك بالدين، وعنده خبرة: {إن خير من استأجرت القوي الأمين} [القصص:26] أمانة وقوة وخبرة، فمن الذين يتولى؟ هل يقول الرجل الصالح: لا.
هذا خطر على قلبي لا.
إذا كان هذا المنصب ليس فيه من المنكرات والآثام والمفاسد أكثر من مصلحة وجودك فيه، فإنه يتعين عليك إنقاذا لمصالح الأمة -التي تستطيع أن تحققها من هذا المنصب- أن تتولى هذا المنصب، ولو كانت المفاسد التي فيه أكبر من المصالح بحيث ربما تفسد أنت في المنصب، بحجة مصلحة المسلمين فلا يجوز لك أن تتولى، وإذا وجد مثلك في الكفاءة لنفس المنصب، فإن الأسلم للقلب أن تبتعد، لكن إذا لم يوجد غيرك، ومثلك في الكفاءة أو كانت المصالح أكثر من المفاسد، فإن توليك له مصلحة شرعية، وينبغي أن تحرص عليها، لا لأجل المنصب والشهرة، وأن يكون لك مكانة بين الناس، ولكن لأجل حماية مصالح المسلمين.
ونرجو بهذا التوضيح الأخير، أن تكون المسألة الآن قد صارت واضحة.
الرياء
ومن المفسدات التي سنذكرها في هذه الليلة أخيرا: الرياء.
والرياء هو عمل الشيء لكي يراك الناس والرياء: هو أن ترائي بعملك، (من راءى، راءى الله به) من فعل ليراه الناس، راءى الله به (ومن سمع سمع الله به) من فعل وأخبر الناس أني عملت وعملت، هذا اسمه تسميع، وهذا الفرق بين الرياء والتسميع، الرياء أن تعمل ليراك الناس، والتسميع أن تخبر الناس بما فعلت، ليسمعوا بك وبفعلك: (ومن سمع سمع الله به).
وإذا فضح الله إنسانا يوم القيامة، فالويل له مما قدمت يداه، فالرياء مفسد للعمل، وإذا كان العمل متصلا ومبنيا أوله على آخره، وإن طرأ عليه الرياء ولم يدافعه فإن العمل يفسد ولا بد من إعادته كالصلاة المفروضة، وأما لو كان العمل منفصلا وراءى في جزء منه أو في شيء منه، كمن تصدق بمائة ريال، وراءى فيها ثم تصدق بمائة أخرى ولم يرائ فيها فليتصدق، فالتي تصدق ولم يراء فيها فهي مقبولة، والتي راءى فيها فهي مردودة، إلا أن يتوب إلى الله من هذا الرياء، فإنها تقبل إن شاء الله.
والرياء محرم، وليس فقط محبطا للعمل، وإنما يترتب عليه إثم، لو أن قائلا قال لك: الرياء فقط يبطل العمل، نقول: لا.
إنه يبطل العمل وتأثم أيضا زيادة على بطلان العمل، تأثم لو أنت تصدقت رياء أمام الناس وأخرجت مائة ريال وجعلت تفرك بها وترفع وتخفض، هذا ليس فقط يحبط عمل المائة أنه ليس لك أجر عليها، ولكن أيضا تأثم بفعل ذلك والدليل أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ثلاثة: (متصدق وقارئ ومجاهد) وكما ورد في الاختلاف بحسب اختلاف الروايات، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: (أولئك خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة، يا أبا هريرة).
فالرياء لا شك أنه من مفسدات القلوب وهو شرك، والله لا يغفر أن يشرك به، ولا بد من توبة مخصوصة له، فبقية الذنوب لو عمل الإنسان حسنات فإنها تمحو بها السيئات، لكن الشرك لا يغفره الله إلا بتوبة، فلا بد أن تتوب له، ولأجل كثرة أنواع الشرك، وصعوبة متابعة الإنسان لكل شرك بتوبة، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء، فقال: (اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه).
لأنك قد تكون وقعت في الشرك، فتقول بذمتك، وهذا شرك، وهذا أبسط الأشياء، فقولك: (بذمتك صار كذا)، فإذا ينبغي الحذر من الشرك بجميع أنواعه وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} [النساء:48] أنه داخل في الشرك الأكبر والأصغر.
وما هو الحل والعلاج من الرياء؟ علاجات الرياء أشياء كثيرة جدا: منها: محاولة إخفاء العمل على الدوام، وألا يجر ذلك إلى التقاعس، وهناك أشياء لا تخفى كصلاة الجمعة والجماعة، أن تأتي بقناع إلى المسجد، فهذا لا بد من الظهور فيه، لكن الصدقة قد تخفيها إلا إذا ترتبت مصلحة كبرى من إظهارها، مثل ما فعل الرجل، (وجعل الرجل يأتي بصرة حتى كادت كفه تعجز عنها، ثم تتابع الناس فكان قدوة للآخرين) هذا فيه مصلحة شرعية.
وإلا الأصل إخفاء الصدقات، وهكذا الحرص على إخفاء العمل وبالذات الأشياء التي ليس من السنة إظهارها، كقيام الليل، ثم إن الإنسان إذا أدى العمل فيراقب نفسه قبل أدائه، لأنه سيعمله لله، لأن العبد لا تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عما عمل في حياته، لم عملته وكيف عملته، أهو موافق للسنة؟ أهو لله أو لغير الله؟ {فوربك لنسألنهم أجمعين * عما كانوا يعملون} [الحجر:92 - 93] {فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين} [الأعراف:6].
كذلك احتقار العمل فهناك شيء مهم جدا وهو أن الإنسان مهما عمل من الصالحات فعليه أن يحتقر العمل، ويقول بينه وبين نفسه أن ما عمله حقير وأنه لا شيء بالنسبة لما هو مطلوب منه، ولو صلى كذا وكذا ركعة، وأنفق كذا وكذا من المبالغ الطائلة فإنه لا شيء بالنسبة لحق الله عليه، ينبغي أن يشعر أنه ما عمل شيئا وأنه لعله ينجو: {والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون} [المؤمنون:60] يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة: الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، يخاف ألا يقبل منه، يرجو الله أن يقبل، ويخشى من ألا يقبل منه فهو معلق بين الخوف والرجاء.
ومن العلاجات: أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أهم من العمل نفسه، الآن مثلا: أنت تصلي وتحرص على إتمام الصلاة، وأن تجعل ظهرك ليس للأعلى ولا للأسفل وأنه مستو، وأنك تحرص على ضم اليدين عند السجود، وأن تستقبل به القبلة عند السجود وإذا رفعت، فلا هي مضمومة ولا هي مفرقة بين بين، وأنها مبسوطة وأنها حيال المنكبين، أو الأذنين، أو أنها على صدرك، أو بين الثديين كما قال أهل العلم، وأنك تشير بالأصبع وأنت تحرص على تصحيح صورة العمل، هذا ممتاز ومهم جدا، لكن ما هو الأهم منه؟ إنه تصحيح العمل نفسه، أي أن يكون العمل لله، أهم من تصحيح صورة العمل، وكلا الصورتين مهمة، الأولى: تتعلق بالإخلاص، والثانية: تتعلق بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
والأمر الآخر: محاسبة النفس، هل راءيت فتتوب إلى الله، وما فعلته لله، هل قمت به لأجل الله أو لأجل فلان؟ مددت يدي لله، أو لأجل فلان؟ إن ترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها يؤدي إلى الهلاك، قال الله عز وجل: {ليسأل الصادقين عن صدقهم} [الأحزاب:8].
فإذا سئل الصادقون فما بالك بغيرهم، يسأل الصادقون عن صدقهم، فما بالك بغيرهم، فما بالك بالكاذبين، والتأمل في حال السلف من العلاجات، كيف كانوا يخفون أعمالهم، كيف كانوا يحتقرون أعمالهم، قال: محمد بن واسع -انظر هؤلاء سلف وكبار، وجهابذة، وعباد وصلحاء- يقول محمد بن واسع: "لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي من أهل الأرض".
وقال أيوب السختياني: "إذا ذكر الصالحون، كنت عنهم بمعزل" أنا لا أعد نفسي من هذه الزمرة، هم أعلى وأنا أدنى من ذلك، وكان عمر يقول: [اللهم اغفر لي ظلمي وكفري، فقالوا: يا أمير المؤمنين! هذا ظلم، فما بال الكفر، قال: قال الله عز وجل: ((إن الإنسان لظلوم كفار)) [إبراهيم:34]] كفر النعمة، إن أسهل شيء يقع فيه الناس كفر النعمة وقال يونس بن عبيد: "إني لأجد مائة خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي منها واحدة".
وكذلك فإن محاسبة النفس بأن ينظر العبد في حق الله عليه أولا، ثم ينظر هل قام به كما ينبغي، ينظر في حق الله، ماذا يجب عليه لله ثانيا وهذا يؤدي إلى ترك الإعجاب بالعمل، لأن من الأشياء السيئة أن يعجب الإنسان بعمله، ويشعر أنه عبد الله كما ينبغي فيقول: اليوم أنا عبادتي كاملة، والعجب بالعمل مصيبة، لذلك يقال في الآثار: لو أن عبدا عبد الله كذا وكذا سنة، ثم شعر بأنه احتقر عمله، فلحظة الاحتقار قد تكون أعلى وأكمل من كذا وكذا سنة عبادة، لأن العبادة قد تشعر الإنسان بالعجب، وإذا شعر بأنها قليل، وأنه لم يعمل شيئا بالنسبة لحق الله، ولا بد من المزيد، يجتهد في العمل، وذكر الإمام أحمد عن بعض أهل العلم أن رجلا قال لأحد أهل العلم: إني لأقوم في صلاتي فأبكي حتى يكاد البقل ينبت من دموعي، فقال: "إنك إن تضحك وأنت تعترف لله بخطيئتك، خير لك من أن تبكي وأنت تدل بعملك".
وهذه قصة لطيفة وجميلة نختم بها كلامنا، ذكرها ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان يقول: عن جعفر بن زيد قال: خرجنا في غزاة إلى كابول، -تصور، المسلمون وصلوا إلى كابول منذ قديم الزمان- خرجنا في غزاة إلى كابول وفي الجيش صلة بن أشيم وكان أحد الصالحين، فنزل الناس عند العتمة، فصلوا، ثم اضطجع هو فقلت: لأرمقن عمله فأنظر ماذا يصنع هذه الليلة، فالتمس غفلة الناس - الناس ناموا وغفلوا- حتى إذا قلت هدأت العيون وثب، فدخل غيضة - مكان ملتف بالأشجار وخفي- قريبا منا ودخلت على إثره، فتوضأ ثم قام يصلي وجاء أسد - من أسود الغابة الموجودة- وجاء أسد حتى دنا منه، فصعدت في شجرة -المراقب خاف- قال جعفر بن زيد: فتراه التفت أو عده جروا فلما سجد قلت: الآن يفترسه، فجلس من السجود ثم سلم، ثم قال: أيها السبع! اطلب الرزق من مكان آخر، فولى وإن له لزئير، تصدع الجبال منه، قال: فما زال ذلك يصلي حتى كان عند الصبح جلس - لما صار قريبا من الصبح - فحمد الله بمحامد ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، فمثلي لا يجترئ أن يسألك الجنة -طبعا هذا تواضع من العبد، وذلة بين يدي الله، لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يسأل الله عز وجل الجنة بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نسأل الله الفردوس الأعلى، لكن في بعض الأحيان، قد يكون العبد فيه تواضع وذلة بين يدي الله لدرجة أنه يقول: مثل هذا الكلام تعبيرا عن تواضعه- قال: ثم رجع وأصبح كأنه بات على الحشايا، وأصبحت وبي من الفزع شيء الله به عالم.
فكانوا هكذا يخفون أعمالهم، هكذا يعبدون الله، وهكذا يحتقرون الأعمال، ولأجل ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى وأيدهم، وجعلهم فاتحين، وقدوة للأمم والعالم.
وكما جعلت حياة البدن بالطعام والشراب، فحياة القلب بدوام ذكر الله والإنابة إليه، وترك الذنوب، وإذا زادت الذنوب علا الران على القلب، حتى يتغلف ولذلك قال بعض السلف: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: الموطن الأول: عند سماع القرآن.
الموطن الثاني: في مجال الذكر.
الموطن الثالث: في أوقات الخلوة.
فإن لم تجده في هذه المواطن، فاسأل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك.
الخواطر السيئة والاسترسال فيها
ومن الأمور التي تفسد القلب أيضا: الخواطر السيئة والاسترسال فيها، وقد ذكرنا قبل قليل أن مجرد مرور الخاطر لا يمكن للإنسان أن يدفعه بل لابد أن يخطر ببالك شيء، لكن الخطر عندما تسترسل في الخواطر السيئة وتتمادى فيها، فإن مبدأ كل عمل خواطر وأفكار، الخاطرة تصبح فكرة، والفكرة تصبح تصورا، والتصورات تدعو للإرادة، والإرادة تقتضي وقوع الفعل، وإذا وقع الفعل بكثرة وتكرر وصار عادة، فأنى لهم بعد ذلك أن يغيروا.
فإذا: متى تصلح أعمالك؟ إذا صلحت خواطرك التي تخطر في قلبك ونفسك، وصارت خواطر طيبة، وإذا صارت الخواطر السيئة دائما تخطر ببال الإنسان كالفواحش والحرام، والكسب المحرم، ويخطر بباله الظلم وأنه يريد أن يبطش.
إذا كثرت الخواطر السيئة والإنسان لم يدافعها ولا استعاذ بالله منها، واسترسل فيها وتمادى، تتحول إلى ملكات في النفس راسخة، ثم تضغط على الجوارح حتى تصبح فعلا، فيفعل ما خطر بباله من المحرمات، والإنسان لا يمكنه منع نفسه من الخواطر، إلا أن قوة الإيمان تعين على دفع الخواطر الرذيلة.
انظر إلى حال الصحابة، يعني: أحيانا تأتي لأحدهم الخواطر في ذات الله سبحانه وتعالى، (قالوا: يا رسول الله! إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن يحترق حتى يصير حمما، أحب إليه من أن يتكلم به) تأتينا أحيانا خواطر في ذات الله، لو أني ترديت من جبل أو احترقت حتى صرت فحما ولا أن أتكلم به، فقال عليه الصلاة والسلام: (الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ذاك صريح الإيمان) يعني: إذا أنت توصلت إلى التحرج من هذه الخواطر لدرجة أنك تتردى من جبل، وتهلك وتحترق ولا تتكلم بها معناه أنك إنسان عندك إيمان قوي، ولذلك خنس الشيطان في نفسك ولم يقدر عليك إلا بهذه الخواطر تكرهها وتدافعها ما استطعت، والله سبحانه وتعالى خلق النفس شبيهة الرحى، ما هو الرحى؟ آلة الطحن، ولا تسكن، خلق النفس شبيهة بالرحى لا تسكن، هذا تمثيل جيد، ذكره ابن القيم رحمه الله وهذه الرحى التي لا تسكن لا بد لها من حب تطحنه، فإذا طحنت حبا خرج دقيقا جديدا، كان الحب قمحا فخرج طحينا جيدا، وإذا كان ترابا وحصى ماذا يخرج الطحن؟ وإذا كان في الطاحون شيء من القمح، ثم جاء إنسان بسطل من التبن وفتح الطاحون ووضعه فيه، فماذا سيحدث؟ يختلط الطيب والرديء، فانظر في نفسك ما هي الأفكار التي تدور فيها؟ فإذا كان ما يدور في نفسك قمحا جيدا ستكون النتيجة عملا جيدا، ودقيقا نافعا.
وإذا كانت الخواطر التي تدور في نفسك خواطر سوء معناها أن النتيجة التي ستخرج بعد الطحن ستكون أعمالا سيئة، وإذا كان مخلوط بينهما، يخرج لك مثل الدقيق المخلوط بالتبن والعلف وهذا حال النفس وما يأتي فيها من الخواطر الطيبة والرديئة.
حب الرئاسة
بقي لنا أيها الإخوة من الكلام في هذا لموضوع نقطتان: الأولى: تتعلق بحب الرئاسة، والثانية: تتعلق بالرياء، ثم الإجابة عن بعض الأسئلة.
أما بالنسبة لحب الرئاسة فإن حب الرئاسة شهوة خفية في النفس، وطمع يسعى إليه كل من في قلبه شيء من محبة هذه الأمور، فإن أكثر الناس يحب أن يكون ظاهرا ومعظما، رئيسا مطاعا وإليه الأمر في الأمور، وأن يؤخذ برأيه ومشورته، ونحو ذلك.
ونظرا لأن حب الرئاسة أو لأن الرئاسة إذا حصلت، يقع كثير من الناس بسببها في الظلم وفساد النية؛ لأن أصحاب المراكز دائما الأنظار والأضواء مسلطة عليهم، جاء فلان وحضر فلان، فيقع في نفس الشخص شيء من كثرة ذكره بين الناس، وأنه شخص مهم، وبالتالي يقع فساد في قلبه من جراء هذا الأمر خصوصا إذا بدأ الناس يتزلفون إليه، وقد يصرفون إليه شيئا من الأشياء التي لا تجوز إلا لله، من أجل أن يحصلوا على مكاسب من ورائه فيتخذونه سلما ويصرفون إليه أشياء من هذه الأمور التي فيها معاني العبودية، نظرا لذلك كانت الرئاسة مسألة خطيرة، وكان للسلف مواقف منها، وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه واحد يطلب إمارة لم يعطه، قال: (إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله) جاء واحد يسأل الإمارة فقال: (يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها -أي أعطيت لك- أوكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها) لو أعطيتها من غير مسألة وقيل لك: تول قلت: لا أريد، ثم ألزموك بها، فسيعينونك رغما عنهم؛ لأنهم هم الذين ورطوك في الأمر وأنت كاره له، فلا بد أن يعينوك، وإلا فلا تقبل بهذه، ولأن الرئاسة أو الإمارة فيها إفساد للقلب، ابتعد عنها كثير من السلف، وكانوا يتعوذون بالله منها كما يتعوذون من الشيطان، وهذا الذي يفسر لنا عزوف بعض السلف عن القضاء، يخشى من المنصب، ويخشى أن يظلم الناس بسببه، وكان ربما ضرب بعضهم وسجن ليتولى القضاء ويرفض ذلك.
فإن قال قائل، لكن الناس لا بد لهم من رؤساء، ولا بد لهم من قواد، فكيف نفعل؟ فنقول: في الوضع الإسلامي والجو الإسلامي، عندنا نماذج ما حدث في عهد أبي بكر وعمر، وقول أبي بكر لما بويع، طلب من الناس إذا وجدوه على خير أن يعينوه وإذا وجدوه على باطل أن ينقدوه ويصوبوه، وكان عمر دقيقا في محاسبة الولاة، وكان يعزل ويولي على أشياء بالدقة والإتقان، ويجعل العيون على الولاة، وكانت تأتي إليه أخبارهم بالدقة دائما وهذا في عهد السلف ولا بد أن نفهم هذه القضية، في عهد السلف كان الأكفاء وأهل العلم كثر، إذا تدافعوا القضاء سيتولى واحد من أهل العلم، لأن أهل العلم كثر، وكذلك إذا ولي فلان ولايات، هناك من الأكفاء وأهل الطاعة والإيمان والقدرة كثر، إنه مجتمع إسلامي ناضج وفيه خبرات متفتحة، فلما تدافعوا كان تدافعهم من أجل أنه وجد أكفاء يديرون الأمور، فلو دفع عن نفسه؛ لا يحصل بسبب ذلك ضرر على المجتمع، لكن نحن الآن في وضعنا ماذا نفعل، تعالوا ننظر في حال يوسف عليه السلام {اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم} [يوسف:55] لماذا طلب يوسف المنصب؟ وكيف يطلب يوسف المنصب؟ ونحن نتكلم الآن عن حب الرئاسة، نقول: إن يوسف كان يعلم، ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه، أنه كان لديه خبرة وقدرة على إدارة أمور التخزين، والصرف للناس بشيء من القدرة التي أعطاه الله إياها، ولم يكن يوجد في البلاد مثله ولا قريبا منه، فلأجل صالح الناس العام طلب أن يتولى ذلك المنصب، ولذلك نقول: إذا قل الأكفاء، فلا بد أن يولى الأكفاء وإذا ولي الأكفاء، فلا بد أن يربوا لأنه لو لم يتول هذا المنصب، لجاء آخر فأفسد فيه، لكن لو وجد من يتولى المنصب مثله في الكفاءة، أو قريبا منه، فالأسلم للقلب في هذه الحالة أن يبتعد عن المنصب، فلو كان يشغل المنصب عندنا فاسق وإنسان متمسك بالدين، وعنده خبرة: {إن خير من استأجرت القوي الأمين} [القصص:26] أمانة وقوة وخبرة، فمن الذين يتولى؟ هل يقول الرجل الصالح: لا.
هذا خطر على قلبي لا.
إذا كان هذا المنصب ليس فيه من المنكرات والآثام والمفاسد أكثر من مصلحة وجودك فيه، فإنه يتعين عليك إنقاذا لمصالح الأمة -التي تستطيع أن تحققها من هذا المنصب- أن تتولى هذا المنصب، ولو كانت المفاسد التي فيه أكبر من المصالح بحيث ربما تفسد أنت في المنصب، بحجة مصلحة المسلمين فلا يجوز لك أن تتولى، وإذا وجد مثلك في الكفاءة لنفس المنصب، فإن الأسلم للقلب أن تبتعد، لكن إذا لم يوجد غيرك، ومثلك في الكفاءة أو كانت المصالح أكثر من المفاسد، فإن توليك له مصلحة شرعية، وينبغي أن تحرص عليها، لا لأجل المنصب والشهرة، وأن يكون لك مكانة بين الناس، ولكن لأجل حماية مصالح المسلمين.
ونرجو بهذا التوضيح الأخير، أن تكون المسألة الآن قد صارت واضحة.
الرياء
ومن المفسدات التي سنذكرها في هذه الليلة أخيرا: الرياء.
والرياء هو عمل الشيء لكي يراك الناس والرياء: هو أن ترائي بعملك، (من راءى، راءى الله به) من فعل ليراه الناس، راءى الله به (ومن سمع سمع الله به) من فعل وأخبر الناس أني عملت وعملت، هذا اسمه تسميع، وهذا الفرق بين الرياء والتسميع، الرياء أن تعمل ليراك الناس، والتسميع أن تخبر الناس بما فعلت، ليسمعوا بك وبفعلك: (ومن سمع سمع الله به).
وإذا فضح الله إنسانا يوم القيامة، فالويل له مما قدمت يداه، فالرياء مفسد للعمل، وإذا كان العمل متصلا ومبنيا أوله على آخره، وإن طرأ عليه الرياء ولم يدافعه فإن العمل يفسد ولا بد من إعادته كالصلاة المفروضة، وأما لو كان العمل منفصلا وراءى في جزء منه أو في شيء منه، كمن تصدق بمائة ريال، وراءى فيها ثم تصدق بمائة أخرى ولم يرائ فيها فليتصدق، فالتي تصدق ولم يراء فيها فهي مقبولة، والتي راءى فيها فهي مردودة، إلا أن يتوب إلى الله من هذا الرياء، فإنها تقبل إن شاء الله.
والرياء محرم، وليس فقط محبطا للعمل، وإنما يترتب عليه إثم، لو أن قائلا قال لك: الرياء فقط يبطل العمل، نقول: لا.
إنه يبطل العمل وتأثم أيضا زيادة على بطلان العمل، تأثم لو أنت تصدقت رياء أمام الناس وأخرجت مائة ريال وجعلت تفرك بها وترفع وتخفض، هذا ليس فقط يحبط عمل المائة أنه ليس لك أجر عليها، ولكن أيضا تأثم بفعل ذلك والدليل أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ثلاثة: (متصدق وقارئ ومجاهد) وكما ورد في الاختلاف بحسب اختلاف الروايات، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: (أولئك خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة، يا أبا هريرة).
فالرياء لا شك أنه من مفسدات القلوب وهو شرك، والله لا يغفر أن يشرك به، ولا بد من توبة مخصوصة له، فبقية الذنوب لو عمل الإنسان حسنات فإنها تمحو بها السيئات، لكن الشرك لا يغفره الله إلا بتوبة، فلا بد أن تتوب له، ولأجل كثرة أنواع الشرك، وصعوبة متابعة الإنسان لكل شرك بتوبة، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء، فقال: (اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه).
لأنك قد تكون وقعت في الشرك، فتقول بذمتك، وهذا شرك، وهذا أبسط الأشياء، فقولك: (بذمتك صار كذا)، فإذا ينبغي الحذر من الشرك بجميع أنواعه وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} [النساء:48] أنه داخل في الشرك الأكبر والأصغر.
وما هو الحل والعلاج من الرياء؟ علاجات الرياء أشياء كثيرة جدا: منها: محاولة إخفاء العمل على الدوام، وألا يجر ذلك إلى التقاعس، وهناك أشياء لا تخفى كصلاة الجمعة والجماعة، أن تأتي بقناع إلى المسجد، فهذا لا بد من الظهور فيه، لكن الصدقة قد تخفيها إلا إذا ترتبت مصلحة كبرى من إظهارها، مثل ما فعل الرجل، (وجعل الرجل يأتي بصرة حتى كادت كفه تعجز عنها، ثم تتابع الناس فكان قدوة للآخرين) هذا فيه مصلحة شرعية.
وإلا الأصل إخفاء الصدقات، وهكذا الحرص على إخفاء العمل وبالذات الأشياء التي ليس من السنة إظهارها، كقيام الليل، ثم إن الإنسان إذا أدى العمل فيراقب نفسه قبل أدائه، لأنه سيعمله لله، لأن العبد لا تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عما عمل في حياته، لم عملته وكيف عملته، أهو موافق للسنة؟ أهو لله أو لغير الله؟ {فوربك لنسألنهم أجمعين * عما كانوا يعملون} [الحجر:92 - 93] {فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين} [الأعراف:6].
كذلك احتقار العمل فهناك شيء مهم جدا وهو أن الإنسان مهما عمل من الصالحات فعليه أن يحتقر العمل، ويقول بينه وبين نفسه أن ما عمله حقير وأنه لا شيء بالنسبة لما هو مطلوب منه، ولو صلى كذا وكذا ركعة، وأنفق كذا وكذا من المبالغ الطائلة فإنه لا شيء بالنسبة لحق الله عليه، ينبغي أن يشعر أنه ما عمل شيئا وأنه لعله ينجو: {والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون} [المؤمنون:60] يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة: الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، يخاف ألا يقبل منه، يرجو الله أن يقبل، ويخشى من ألا يقبل منه فهو معلق بين الخوف والرجاء.
ومن العلاجات: أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أهم من العمل نفسه، الآن مثلا: أنت تصلي وتحرص على إتمام الصلاة، وأن تجعل ظهرك ليس للأعلى ولا للأسفل وأنه مستو، وأنك تحرص على ضم اليدين عند السجود، وأن تستقبل به القبلة عند السجود وإذا رفعت، فلا هي مضمومة ولا هي مفرقة بين بين، وأنها مبسوطة وأنها حيال المنكبين، أو الأذنين، أو أنها على صدرك، أو بين الثديين كما قال أهل العلم، وأنك تشير بالأصبع وأنت تحرص على تصحيح صورة العمل، هذا ممتاز ومهم جدا، لكن ما هو الأهم منه؟ إنه تصحيح العمل نفسه، أي أن يكون العمل لله، أهم من تصحيح صورة العمل، وكلا الصورتين مهمة، الأولى: تتعلق بالإخلاص، والثانية: تتعلق بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
والأمر الآخر: محاسبة النفس، هل راءيت فتتوب إلى الله، وما فعلته لله، هل قمت به لأجل الله أو لأجل فلان؟ مددت يدي لله، أو لأجل فلان؟ إن ترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها يؤدي إلى الهلاك، قال الله عز وجل: {ليسأل الصادقين عن صدقهم} [الأحزاب:8].
فإذا سئل الصادقون فما بالك بغيرهم، يسأل الصادقون عن صدقهم، فما بالك بغيرهم، فما بالك بالكاذبين، والتأمل في حال السلف من العلاجات، كيف كانوا يخفون أعمالهم، كيف كانوا يحتقرون أعمالهم، قال: محمد بن واسع -انظر هؤلاء سلف وكبار، وجهابذة، وعباد وصلحاء- يقول محمد بن واسع: "لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي من أهل الأرض".
وقال أيوب السختياني: "إذا ذكر الصالحون، كنت عنهم بمعزل" أنا لا أعد نفسي من هذه الزمرة، هم أعلى وأنا أدنى من ذلك، وكان عمر يقول: [اللهم اغفر لي ظلمي وكفري، فقالوا: يا أمير المؤمنين! هذا ظلم، فما بال الكفر، قال: قال الله عز وجل: ((إن الإنسان لظلوم كفار)) [إبراهيم:34]] كفر النعمة، إن أسهل شيء يقع فيه الناس كفر النعمة وقال يونس بن عبيد: "إني لأجد مائة خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي منها واحدة".
وكذلك فإن محاسبة النفس بأن ينظر العبد في حق الله عليه أولا، ثم ينظر هل قام به كما ينبغي، ينظر في حق الله، ماذا يجب عليه لله ثانيا وهذا يؤدي إلى ترك الإعجاب بالعمل، لأن من الأشياء السيئة أن يعجب الإنسان بعمله، ويشعر أنه عبد الله كما ينبغي فيقول: اليوم أنا عبادتي كاملة، والعجب بالعمل مصيبة، لذلك يقال في الآثار: لو أن عبدا عبد الله كذا وكذا سنة، ثم شعر بأنه احتقر عمله، فلحظة الاحتقار قد تكون أعلى وأكمل من كذا وكذا سنة عبادة، لأن العبادة قد تشعر الإنسان بالعجب، وإذا شعر بأنها قليل، وأنه لم يعمل شيئا بالنسبة لحق الله، ولا بد من المزيد، يجتهد في العمل، وذكر الإمام أحمد عن بعض أهل العلم أن رجلا قال لأحد أهل العلم: إني لأقوم في صلاتي فأبكي حتى يكاد البقل ينبت من دموعي، فقال: "إنك إن تضحك وأنت تعترف لله بخطيئتك، خير لك من أن تبكي وأنت تدل بعملك".
وهذه قصة لطيفة وجميلة نختم بها كلامنا، ذكرها ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان يقول: عن جعفر بن زيد قال: خرجنا في غزاة إلى كابول، -تصور، المسلمون وصلوا إلى كابول منذ قديم الزمان- خرجنا في غزاة إلى كابول وفي الجيش صلة بن أشيم وكان أحد الصالحين، فنزل الناس عند العتمة، فصلوا، ثم اضطجع هو فقلت: لأرمقن عمله فأنظر ماذا يصنع هذه الليلة، فالتمس غفلة الناس - الناس ناموا وغفلوا- حتى إذا قلت هدأت العيون وثب، فدخل غيضة - مكان ملتف بالأشجار وخفي- قريبا منا ودخلت على إثره، فتوضأ ثم قام يصلي وجاء أسد - من أسود الغابة الموجودة- وجاء أسد حتى دنا منه، فصعدت في شجرة -المراقب خاف- قال جعفر بن زيد: فتراه التفت أو عده جروا فلما سجد قلت: الآن يفترسه، فجلس من السجود ثم سلم، ثم قال: أيها السبع! اطلب الرزق من مكان آخر، فولى وإن له لزئير، تصدع الجبال منه، قال: فما زال ذلك يصلي حتى كان عند الصبح جلس - لما صار قريبا من الصبح - فحمد الله بمحامد ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، فمثلي لا يجترئ أن يسألك الجنة -طبعا هذا تواضع من العبد، وذلة بين يدي الله، لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يسأل الله عز وجل الجنة بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نسأل الله الفردوس الأعلى، لكن في بعض الأحيان، قد يكون العبد فيه تواضع وذلة بين يدي الله لدرجة أنه يقول: مثل هذا الكلام تعبيرا عن تواضعه- قال: ثم رجع وأصبح كأنه بات على الحشايا، وأصبحت وبي من الفزع شيء الله به عالم.
فكانوا هكذا يخفون أعمالهم، هكذا يعبدون الله، وهكذا يحتقرون الأعمال، ولأجل ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى وأيدهم، وجعلهم فاتحين، وقدوة للأمم والعالم.











.jpg)







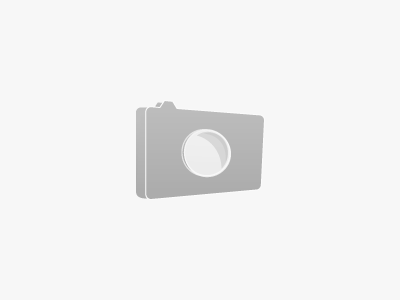
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق